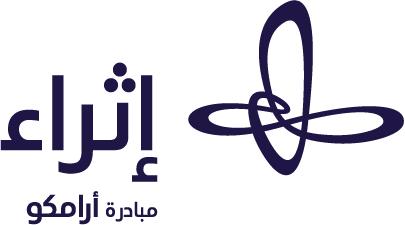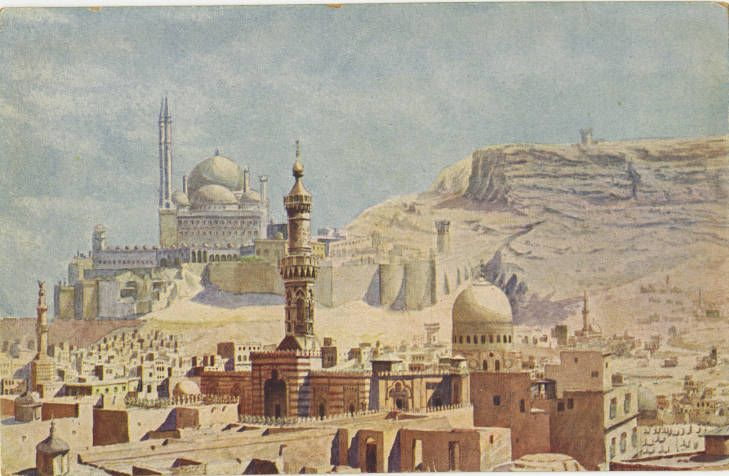بعد الضجّةِ التي أثارها “سام ألتمان” الرئيسُ التنفيذيُّ لشركة OpenAI بفكرةِ الاستخدامِ المُذهلِ للذكاءِ الاصطناعيِّ، بدأت تتشكّلُ أنماطٌ مختلفةٌ من الاستخدامِ العقيم أو النافع للعديد من المستخدمين حول العالم.
شخصيًّا، أرى أن تجربتي مع الذكاءِ الاصطناعيِّ في تطوّرٍ رائعٍ للغاية، إذ كنتُ قد أنهيتُ حصولي على شهادةِ التخطيطِ الاستراتيجيِّ الاحترافيّة قبل فترةٍ وجيزة، فكان أحدُ متطلّباتِ اجتيازِ المادةِ التعليميّة كتابةَ خمسةِ آلافِ كلمةٍ، وذلك بوضعِ سيناريو لشركةٍ متوسطةِ الحجمِ تريد أن تضعَ خطّتَها الاستراتيجيّةَ للعشرِ أعوامٍ المقبلة.
وضعتُ الجهازَ المحمولَ على المكتبة، وبدأتُ في إصدارِ الأوامرِ للمحادثةِ القادمةِ بيني وبين الذكاءِ الاصطناعيِّ، فأمرتُه بألّا يُعطيني الإجاباتِ مطلقًا، إنّما أنا من سيقومُ بالإجابة، وما عليه إلا أن يُصحّحني إن أخطأت، ويُخبرني أينَ هي بالضبط مكامنُ الخللِ التي وقعتُ فيها، ويُرشدني إلى الطريقةِ السليمةِ من أجل تصحيحِها على النحوِ الأمثل.
وهكذا، على مدارِ خمسةِ أيامٍ متواصلةٍ، أُجيبُ أنا وهو يُقوّمني، حتى انتهيتُ من الواجبِ المقرّرِ عليّ، وكلَّ يومٍ أقومُ فيه بهذه المحادثات أكون أكثر دهشةً، وكأنّه مرآةٌ لأفكاري التي أقومُ بتطبيقها على أرض الواقع، مع تصحيحٍ للخطأ، وتنبيهٍ للجواب الأكثر صوابًا. أنهيتُ مهمّةَ كتابةِ الواجبِ المشتركة بيني وبين الذكاءِ الاصطناعيِّ وأنا في قمّةِ الرضا، دون شعورٍ بوخزٍ في الضميرِ يُؤنّبني على استعانتي المطلقةِ به، ولكي أتفادى أيضًا الفكرةَ السيّئةَ الأخرى التي قد تتمثّلُ فيما يعرفُه الكثيرُ من صُنّاعِ المحتوى بـ متلازمةِ المحتال!
هذه التجربةُ المثيرةُ للاهتمامِ بالنسبةِ لي تطوّرت لاحقًا لتصبح محادثةً بيني وبين الذكاءِ الاصطناعيِّ، ولكن هذه المرة كانت صوتيّةً، تحدثنا فيها عن كتابِ تيم مارشال (سجناء الجغرافيا) الذي تطرّق فيه كاتبُه إلى الأوضاعِ الجيوسياسيّة عالميًّا بمختلفِ الدول الكبرى. فبعد نهايةِ عددٍ من الصفحات، كنتُ أسجل محادثةٍ طويلةٍ أُخبرُ فيها الذكاءَ الاصطناعيَّ بما فهمتُه، وآمرُه بالنقد لما استوعبتُه، أو أن يُقدّم لي وجهةَ نظرٍ أخرى لم يذكرْها الكاتبُ مطلقًا!
هاتانِ التجربتانِ المثيرتان جعلتاني أفكّرُ كثيرًا حول السؤالِ المهم: «كيف سيؤثّرُ الذكاءُ الاصطناعيُّ على الأفرادِ فيما يتعلّقُ بمستقبلِهم المهنيِّ والتعليميِّ؟»
هل التعليمُ المُخصّصُ للأفرادِ مُفيدٌ حقًّا؟
ما زلتُ في داخلي ناقمًا على أسلوبِ الدراسةِ التعليميّةِ الذي تلقيتُه طوال حياتي، لا أذكرُ الحصصَ الدراسيّةَ التي جعلتني متيقظًا ومشدودًا بدلًا من أن يغالِبُ عينيَّ النعاس. هي مرّةٌ وحيدةٌ لا أنساها حينما قام مُعلّمُ المادةِ في المرحلةِ الجامعيّة بوضعِ دراسةٍ بحثيّةٍ بين أيدينا ونحن في المستوى الأخير في الجامعة، ليقول لنا صراحة: “انتقدوا هذه الدراسةَ البحثيّة؛ ما هي نقاطُ قوّتِها وضعفِها؟ وما هي الحدودُ (Limitation) التي واجهتْها هذه الدراسةُ في تطبيقِها؟”
لا زلتُ أتذكّر حجمَ الإرباكِ الذي سبّبَه أستاذُ المادةِ في الصف، ولا أُبالغ بأنّ كلَّ ما قاله لم يكن إلا شكلًا جديدًا من أشكالِ التعليمِ الذي لم أتلقَّه أنا وزملائي مطلقًا. بعد سؤالِه، عمَّ الصمتُ المكان، وعلت على المعلّمِ نظراتُ الخيبة، وهو القادمُ كضيفٍ من خارج الجامعة يريد أن يُبلور حجمَ التعليمِ الذي حظي به طلابُه في مسيرتهم الجامعية ممن سيساهمون في دف عجلة التنمية في المستقبل القريب، ولكن لم يلبث مثلُ هذا الأملِ إلا وأن تلاشى سريعًا!
في دراسةٍ أُجريت عام 1984 م تحت مسمّى Bloom 2-Sigma تناولت الفرق بين طرقِ التدريسِ التقليديّةِ القائمةِ على المجموعاتِ، مقارنةً بالتعليمِ المُخصّصِ للأفرادِ (مُعلّمٌ واحدٌ لكلِّ طالب). أظهرتِ الدراسةُ أنّ الطلبةَ الذين حظوا بانتباهِ المعلّمِ المباشرِ لهم حصلوا على تعليمٍ أفضلَ من نظرائِهم بنسبةٍ استثنائيّةٍ وصلتْ إلى 98%، وبزيادةِ انحرافَين معياريَّين فوق مستوى زملائهم في الصف التقليدي، بمعنى أنهم انتقلوا لمستوى أعلى بكثير من المتوسط العادي للطلبة.
هذه الدراسةُ أثبتت أنّ قدراتِ الطلابِ ليست المشكلةَ، بل الطريقةَ التعليميّةَ نفسها التي يتمُّ اعتمادُها هي المشكلةُ الحقيقيّة. فالطالبُ الذي يُخصَّصُ له معلّمٌ وحدَه سوف يحظى بتغذيةٍ راجعةٍ لحظيّة، مع تصحيحٍ للخطأ إنْ وُجد، ودعمٍ نفسيٍّ مستمرٍّ عند الوصولِ إلى الإجابةِ الصحيحة. وهذا يعود إلى جودةِ التعليم التي يحصلُ عليها الطالبُ من مُعلّمٍ عالي الكفاءة يعرفُه عن قُربٍ ويُشاركه بشكلٍ آنيّ.
كيف ترى المنصّاتُ العالميّةُ شكلَ التعليمِ في المستقبل؟
في إحدى المحاضراتِ التي قدّمها سلمان خان، المؤسّسُ والرئيسُ التنفيذيُّ لأكاديميّةِ خان التعليميّة، بعنوان «كيف بإمكانِ الذكاءِ الاصطناعيِّ إنقاذُ التعليمِ لا تدميرُه»، أكّد أنّ التعليمَ المُخصَّصَ للأفرادِ هو ما سيجعلُهم في الخانةِ الاستثنائيّة. فمن خلال الاستعانةِ بالذكاءِ الاصطناعيِّ، سيتمكّنُ المختصّون من توسيعِ فكرةِ أن يحظى كلُّ طالب بمعلّمِه الخاصّ الذي سيجعلُه مميّزًا وفريدًا من نوعِه.
لاحقًا، ما قام به سلمان خان لم يكن إطلاقَ برنامجٍ فحسب، إنّما محاولةٌ جديرةٌ بالاهتمامِ في كيفيّةِ المحافظةِ على الفكرِ الإبداعيّ غير المنقطع الذي يتمتّع به الأطفالُ في فضولِهم المستمرّ واستكشافِهم للعالمِ من منظورٍ جديدٍ تمامًا. فقد أطلق سلمان خان برنامج Khanmigo، وهو برنامجٌ للمحادثةِ بتقنياتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ مدعومٌ بالأسئلةِ السقراطيّةِ التي لا تُعطي الطالبَ الإجابةَ على طبقٍ من ذهب، بل تسألُه عن معنى إجابته، ولماذا اختارَها دون غيرِها. فهذا البرنامجُ لا يُصحّحُ الخطأ، وإنّما يُعزّزُ المنطقيّةَ بإعادةِ إنتاجِ المعرفةِ عن طريقِ الفردِ المتعلّم، ومن أجلِ تعزيزِ التفكيرِ النقديِّ والذكاءِ البشريّ.
هذه المبادرةُ التي قام بها سلمان خان أوضحت لي بما لا يدعُ مجالًا للشكِّ أنّ طريقتي في التعاطي مع الذكاءِ الاصطناعيِّ مثاليّةٌ للغاية، وليست هي الطريقةَ الخاطئة التي قد أعضّ عليها أصابعَ الندمِ لقاء اشتراكي مع هذه الخدمة.
فطرحي للأسئلةِ السقراطيّة كانت من أجل الفهم، كأن أسأل: كيف أشرح ما فهمتُه بكلماتي الخاصّة؟ وما الدليلُ على ما قلتُه؟ وما الفرقُ بين هذا المفهوم ومفهومٍ آخر؟ وماذا لو غيّرنا أحدَ الافتراضات القائمة؟ وكيف يمكنني تطبيقُ ما تعلّمتُه في الواقع؟ كلُّها ليست إلا من صميمِ التعليمِ الفرديِّ المخصّصِ والمعزَّز بالفكرِ السقراطيّ، من أجلِ هضمِ المعرفةِ وإعادةِ توليدِها، ثم إنتاجِها بطريقةٍ مختلفة، ولكن هذه المرّة بشكل أعمق.
لنأتِ على سؤالٍ مهمّ: إنْ حظي الطلبةُ بمثلِ هذا التعليمِ المُخصّصِ والفعّال، فكيف سيكونُ مستقبلُ المهنِ إذًا؟
ما الذي ستطلبُه الشركاتُ العالميّةُ خلال الأعوامِ المقبلة؟
حينما أسألُ العديدَ من الأشخاصِ حولي عن كيفيّةِ استعدادِهم للمستقبل، يُقابلونني بفكرةِ الاستسلامِ ورؤيةِ المشهدِ من بعيدٍ دون التحرّك معه. مثلُ هذه الردود ستُظهر لنا في المستقبل القريب، مَن كان لديه بُعدُ نظرٍ وخطّةٌ بديلة لتفادي المخاطرِ والاستفادةِ من موجةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ قدرَ الممكن.
دائمًا ما يكون هناك تخوّفٌ من فكرةِ استبدالِ الذكاءِ الاصطناعيِّ لوظائفِ الأفراد؛ فهناك مَن ستستبدلُ وظيفتَه الأتمتةُ والخوارزميات، وآخرُ سيعرفُ بالضبط من أينَ تُؤكَلُ الكتفُ ليخلقَ له الذكاءُ الاصطناعيُّ وظيفةً من العدم!
ففي التقريرِ الصادرِ مؤخرًا عن منتدى الاقتصادِ العالميّ في العام 2025 م، ظهر أنّ السوقَ العالميَّ يتّجهُ بشكلٍ لا يقبلُ الشكَّ نحو تبنّي تقنيات الذكاءِ الاصطناعيّ. حيث يزعمُ التقريرُ أنّ هناك 170 مليون وظيفةٍ سوف تُستحدثُ عالميًّا، بينما في المقابل هناك 92 مليون وظيفةٍ ستُلغى ولن يُعتمَد عليها بعد اليوم.
أشار التقريرُ أيضًا إلى أنّ ثلثي الشركاتِ العالميّةِ سيوظّفون أشخاصًا لديهم معرفةٌ عميقةٌ بتقنياتِ الذكاءِ الاصطناعيّ، بما يشملُ تحليلَ البياناتِ الكبرى (Big Data)، والبرمجةَ التقنية، وتطويرَ البرمجيات.
ومن أجلِ جعلِ هذه العلومِ أكثرَ تأثيرًا، لا بدّ من مهاراتٍ تتعلّقُ بالتفكيرِ التحليليّ، والمرونةِ مع متغيّراتِ السوقِ المختلفة، والقدرةِ على أخذِ المبادرةِ لخلقِ التأثيرِ الاجتماعيّ. وهنا بالضبط يكون الخيارُ بين أن تتبنّى الأدوارَ المتناميةَ، أو ألّا تتحرّكَ مطلقًا، فتركنَ إلى التراجعِ، وبهذا يسحقُكَ التقدّمُ التقنيّ!
كيف يرى الناسُ تأثيرَ الذكاءِ الاصطناعيِّ على حياتِهم في المستقبلِ القريب؟
في تقريرٍ آخرَ منشورٍ من جامعةِ ستانفورد عام 2025 م، وردت إحصاءاتٌ عديدةٌ حول دورِ الذكاءِ الاصطناعيّ، فقد كانت الشركاتُ العالميّةُ عام2023 م قد آمنتْ بالذكاءِ الاصطناعيّ واستخدمتْه بنسبة 55%، لكنّ هذه النسبةَ قفزت في عام 2024 م لتصلَ إلى نسبة أعلى من ذي قبل حيث وصلت إلى 78% كلُّ هذه التغيّراتِ حدثت خلال عامٍ واحدٍ فقط!
ففي الإحصاء نفسِه، حينما سُئل الناسُ عن توقّعاتِهم لدورِ الذكاءِ الاصطناعيِّ في مستقبلِهم المهنيّ، أكّد ثلث المشاركين أنّهم يتوقّعون أثرًا ملموسًا لهذه التقنياتِ في حياتِهم خلال الأعوام الثلاثةِ إلى الخمسةِ القادمة.
ما هو السؤالُ الذي يجبُ أن نطرحهُ على أنفسِنا حين نواجهُ مثلَ هذا المدِّ العالي للذكاءِ الاصطناعيّ؟
في محاضرةٍ لـ لارس تومسن عن مستقبل الذكاء الاصطناعي والعمل والإمكانيات البشرية، وهو المهتمِّ بتحوّلاتِ الذكاءِ والطاقةِ والتحوّلِ الرقميِّ منذ أكثرَ من عشرين عامًا، أكّد أنّنا نعيشُ في عصرٍ مذهلٍ يشبهُ ذلك الفتحَ في القرونِ الماضية حين اكتُشفتْ الورقةُ والقلمُ، والطباعة. سمّى هذا الزمنَ بـ “نقطةِ التحوّلِ الكبرى Tipping Point“.
ولأنّنا في عصرٍ استثنائيّ، دعا في محاضرته إلى تغييرِ الكلمةِ الجامدةِ: بدلَ قولنا الذكاءُ الاصطناعيّ يمكننا أن نطلق عليه “الذكاءُ المُحيطيّ Ambient Intelligence“كأداةٍ داعمةٍ لحياتِنا الشخصيّة. فبإمكانِ هذا الذكاءِ المُحيطيِّ أن يحرّرَنا من الأعمالِ الروتينيّة، ويمنحَنا مُتّسعًا من الوقتِ لنفعلَ ما نحبّ. ومن شأنِ هذه الزيادةِ في جودةِ الحياةِ أن تنعكسَ إيجابًا علينا؛ بوجودِ أفكارٍ خلاّقة، وإبداعٍ مستمرّ، ومعنىً للحياةِ نسعى إليه بالفعل، يُتيحُ لنا قضاءَ وقتٍ مع أُسَرِنا وأصدقائِنا.
لذا، فإنّ السؤالَ الذي يجبُ أن يتبادرَ إلى الذهنِ حين نسمعُ بمصطلحِ الذكاءِ الاصطناعيّ ليس: ما الذي سيفعله بنا؟ بل السؤالُ الحقيقيُّ الذي يجبُ أن نتأمّلَه طويلًا هو: «كيف بإمكاني كفردٍاستغلالُ هذا الذكاءِ الاصطناعيِّ لصالحي وبأفضلِ شكلٍ ممكنٍ، من أجلِ جودةِ حياةٍ أفضلَ ممّا مضى؟»
وأنا بعد هذه التساؤلاتِ والأرقامِ، أميلُ كثيرًا إلى فكرةِ أنّ الذكاءَ الاصطناعيَّ سيمكنُنا من حياةٍ أكثرَ معنىً وتأثيرًا، فالبوادرُ واضحةٌ والقادمُ واعدٌ للغاية.