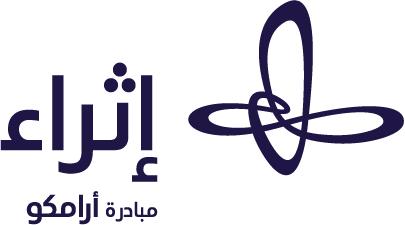كيف يصل الإنسان إلى ذاته؟ وكيف يسمح للخيط الرابط بينه وبين الأشياء والمفاهيم من حوله ألا ينفلت؟ هذا الإنسان الذي لطالما كان مسكونًا بهاجس الوصل، بالخوف من النتوءات، وبرغبة حارقة في التقريب بين المسافات البعيدة لم يتوان يومًا عن بناء الجسور، سواء كانت ماديّةً تصل بين ضفاف الأراضي، أو معنوية تجمع الأحباب، كما الغرباء. فهل تشبهنا الجسور حقًّا؟ وهل تربط بين ضفاف ذواتنا؟
الجسر: أوسع من بناء وأفصح من قصيدة
“الإنسان ابن الجسور”؛ هكذا يصدّر الفيلسوف والكاتب الفرنسيّ ميشيل سير كتابه البديع: “فن الجسور” في رمزية إنسانية فائقة، تتجاوز بنية الجسور وهيكلها الماديّ إلى معانيها الفكرية والإنسانية. لا يكتب “ميشيل” عن هندسة الجسور وتفاصيلها التقنية فحسب، بل يورد احتفاءً بالجسور أيًّا كان نوعها، من لحم أو من معدن، من حجر أو من كلمات، بتلك التي تقرب البشر من بعضهم، وتربط الإنسان بذاته، وتجمع بين الأضداد، ويروي حكايات كثيرة حدثت كتمثّيل للجسور، أو بمقربة منها، أو تحتها، وهي قصص تحاول في كلّ الأحوال أن تقرأ عالمنا وتخفف شدّة وطئه علينا.
سعى “سير” في فلسفته وكتاباته إلى بناء معابر سهلة بين المعارف، بين العلوم الدقيقة والعلوم الإنسانية، بين الفلسفة والفن، وبين العقل والدين، وشغف بمفهوم الجسور بشكل يتجاوز مجرد فلسفة يريد تبنيها؛ الجسور بالنسبة له حاضرة منذ صغره الذي قضاه بين ملّاحي النهر والجرافين، وتحت ظلال الجسرين اللذين تقوم بينهما مدينته آجان، وظلَّ شغفه بها ينمو ويكبر حتى اعترف بأنه يكتب هذا الكتاب كمحاولة لعبور جسرٍ آخر قبل أن يموت. الكتاب أكثر من مجرد حديث عن الجسور، إنه قصيدة بخيط من الحجر والروح والكلمات، قصيدة محب ولهان يرى في الجسور حلولًا لعالم أنهكته الحداثة وعبثت بمعالمه.
تسمح الجسور باستعارة رمزيتها لفهم الإنسان ومراده ودواخله، وفهم هذا العالم الذي يتغير بسرعة شديدة، والذي تطغى سيولته على معالم الحياة، بشكل يجعلنا جميعًا نتوكأ على خشبة تتأرجح بين مدٍّ وجزر، لا قيم ثابتة، ولا مبادئ صارمة، ولا أدنى شعور بالوفاء والتمسك بكل ما هو قديم أو أصيل. ويشير “سير” إلى ذلك بشكل ذكي جدًا ولافت فيقول: “لن نرى بدءا من الآن أي وثاق في العالم، لا الحبال التي تربط السفن، ولا قصبة الصيادين، وإذا شئنا فلن نرى أيضًا الأحزمة التي تشد سروالي” فكل ما يمكن أن يجتمع ليشكل جسرًا غير موجود، لأن الحياة الحديثة أفقدتنا كل شعور بالصلابة أو المتانة التي تشبه ثبات الجسر، كل شيء سلس وسائل، سهل الإمساك، لكنه كذلك سهل الانفلات والفقد.
لا تقتصر الجسور على الهياكل الصلبة فقط؛ فالمعابر، والقنوات، والسدود، والفتحات، والأنفاق والامتحانات جسور هي الأخرى. وبشكلٍ تلقائي يربط “سير” الجسور بالمياه، لأنها في العادة تبنى فوقها. المياه مصدر طاقة متجددة كان يعتمد المهندس عليها بشكل كبير في توليد الطاقة من خلال مد السدود، وبناء الجسور لتحسين نقلها. لكن كل شيء تغير بعد الثورة الصناعية واكتشاف الوقود والطاقات الحارقة. وأصبح العالم بذلك لا يذكر دون حرارة وطاقة، دون إنتاج مستمر يضمن سير عجلة النقود، ويجهد ذات الإنسان بمطالب العمل الكادح ومطالب الاستهلاك المستمرة، بضجيج المدن الصاخبة، واكتظاظ المولات. يقول “سير” في ذلك: “إنّنا لم نعد نذكر العالم دون حرارة، العالم الصامت من دون دخان. إنّنا صمٌّ لشدّة ما تحدثه الحرارة من زفير واهتزاز وصفير. إن عالمنا الساخن يرنّ ويصمّ آذاننا بإشارات لا معنى لها”.
هذا العالم شديد الحرارة على حدّ تعبير “سير” حرق تلك الخيوط والروابط التي كانت تجمع بين الأفراد، وتميز علاقاتهم، وتحفظ اختلافهم، وأصر على حصر الجميع في ثقافة وهوية عولمية واحدة لا يمكن الخروج عنها. الجميع ملزم بارتداء الجينز، والفستان الأبيض، وحمل هواتف الأيفون، وافتتاح الصباح بقهوة من ستاربكس. الجسور تتيح الجمع بين الاختلافات، وتساعد على فهم العالم بأبعاده المتعدّدة، وتحفظ هذا التعدّد فيه، وتحتفي بتناقضاته وكلّ مكوناته غير المتجانسة.
الجسور على عكس الليبرالية التي تغزو عالمنا، وتقسمه ضمن حدود وهمية لا معنى لها، وتجعل من عالم الشمال، والرجل الأبيض مركز اهتمامه، تساعد الأفراد والأفكار على التنقل بين الثقافات والأماكن دون قيود، ودون استبعاد أي كائن مهما كان عرقه وإيمانه وشكله.
التجسير في كل إنسان ومكان
أينما التفت في هذا العالم ستجد نموذجًا مصغّرًا عن الجسر؛ القواميس مزدوجة اللغة التي تحاول خلق رابط بين الألسنة المتعدّدة، والألياف الطبيعيّة التي تحوّل القنب والكتّان إلى ملابس وملاءات، والطبيعة التي نغير فيها وفي موادها فتتحول إلى ثقافة تعكس هوية كل شعب، والنظرية الرياضية المجردة التي بفضلها تسير السفن والمحركات، والأرقام التي من خلالها تُشكل الحجارة الطرق والجسور والمحطات، والخرائط التي ابتكرها الإنسان لتكون دليلًا له في رحلاته وجسرًا بين تصوره وواقعه، والصلاة اليومية التي يلجأ لها الفرد ليتصل بالآخرة وهو في الدنيا.
الإنسان لديه ميلٌ فطريٌّ نحو تجسير كلّ شيء، الإنسان ابن الجسور. حتّى قدومه إلى هذا العالم كان من خلال جسر ربط بينه وبين الحياة الجديدة، جسرُ الرّحم، وحتّى معجزة خلقه كانت من خلال الجسور؛ تحوّل من البويضة إلى مولود جديد، وانقسمت الخلية الواحدة الأولى إلى مليارات الخلايا المترابطة، والمختلفة والمتناسقة بإحكام شديد.
الجسور موجودة في كل مكان، وحتى فعل الكتابة والحديث والإصغاء لا يعدو كونه جسرًا من نوع آخر. الحديث بين الناس هو قنطرة قديمة تمر عبرها مئات المعلومات كما يرى “سير”، ولولا القدرة على الكلام، لمُزق الإنسان بفعل الإشارات، والصرخات والأنين الصادر من حناجر كسيرة ذات جسر منهار، لا تملك القدرة على صياغة جملة واحدة. والكتابة جسر بين الأزمنة، “الكتابة تُجسّر زماننا” بشكل ثابتٍ متينٍ لا تغيره نوائب الدهر. انظر إلى “مقدّمة ابن خلدون” مثلًا وهي تشكّل معبرًا نحو التاريخ وعلم الاجتماع، وكيف ظل ذلك المعبر كما هو، لم يُمح ولم يزل وكل ذلك بفضل الكتابة.
أما فعل الإصغاء فهو الجسر الذي نفتقده في زماننا بشكل كبير، فالوقت من ذهب/ مال كما تعلمون، ونحن لا نملك الكثير منه لننصت بشكلٍ عميق إلى غيرنا، يقول بيونغ شول هان: “تستند هبة الإصغاء إلى إمكانية إبداء اهتمام تأملي عميق؛ وهو ما لا يمكن للأنا مفرطة النشاط القيام به”. الصوت الصادر عن البيانو مثلًا ليس سوى قنطرة بين حباله الصوتية، وأسماعنا، بين حكاية صاحبه وشجوننا، بين أوتاره والفضاء. “فهل نتفرغ اليوم إلى نقل صوتٍ خرج من النسيان كما خرج من الجحيم بفعل الضرب السّحري على الصندوق ذي الملابس البيضاء والسوداء؟” يقول “سير”، وحتمًا إننا لن نتفرغ في عالمٍ يئن من العولمة.
الجسور هي كذلك بشكل أو بآخر الصورة الأنعم للمدن، هي المعلم الأرفق بالإنسان وسط كل مظاهر السّياسة والقوة والاختلاف. بل هي التي تحفظ الاختلاف المحمود وتهيّئ السّبل إليه في عالم النسخات المكرّرة، ولهذا يقول “سير”: “عندما أقتحم غرفة فأرى مئزرا أبيض ملطخ، أصرخ: هذا كيميائيّ، وعندما أرى تنورة من جلد أمام موقد: هذا حداد، وعندما أرى امرأة في خزانة كتب: مؤرخة… كيف يمكننا اليوم أن نصنف هذه الحرف عندما أدخل الأماكن نفسها، فأراهم جميعًا أمام كمبيوتر؟”
الإنسان ابن الجسور، ومن دون جسور، يعيش المرء في قوقعةٍ مغلقة تخالف طبيعته وفطرته التي تقضي بأن يكون على تواصل دائم مع الأفراد والأشياء من حوله، ومن المؤسف أن الجسور اليوم منهارة أو تكاد، وأنّه حلّت محلها مجموعة من الجدران التي تقف كحاجز يمنع أيّ اتصال، من جدران الحدود الوهميّة التي تعزل الشعوب عن بعضها، إلى جحيم الفردانية الذي يفصل المرء عن عائلته ومن حوله، إلى جنون الطائفية التي تمزّق أوطاننا، إلى الحصار الذي يقهر الشعوب الحرّة ويمنعها عن الظفر بحريّتها.