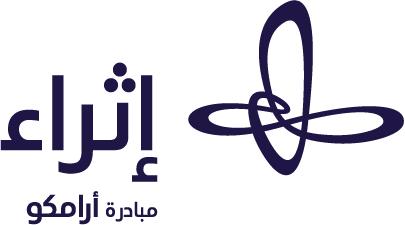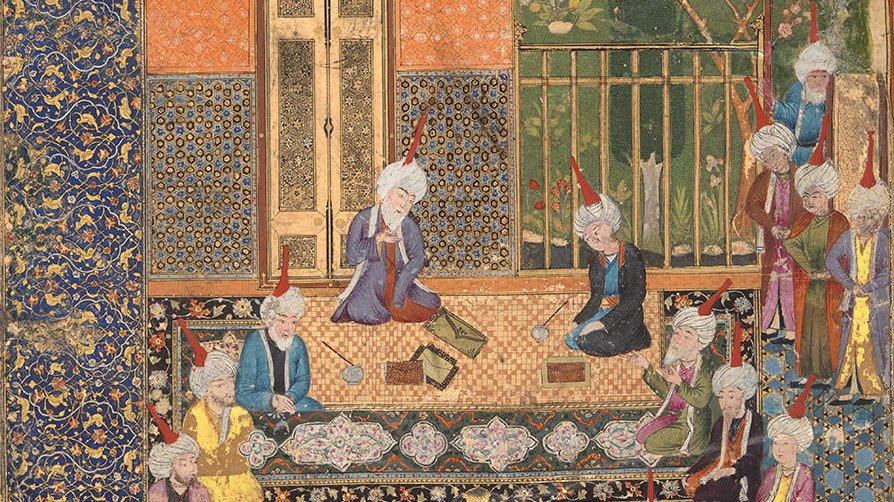عند لحظة غروبٍ في معسكرٍ نازي تملأه رائحة الدم وصمت الألم ويطغى عليه انكسار أرواح السجناء المعذبين جسديًا ونفسيًا، تسللت أشعة الشمس من بين الأشجار في بافاريا، ولعّلها قد أبهرت وجدان أحد السجناء، الذي هرع إلى زملائه ليخبرهم بما رآه من منظر بديع قد تسامى فوق ما يعانونه في تلك اللحظة.
وحينما اجتمع الآخرون لمشاهدة ذلك الغروب الآخاذ، التفت أحدُ السجناء إلى رفيقه وقال بصوتٍ خافت: «كم يمكن أن تكون الدنيا جميلة!»
هذه العبارة التي التقطها فيكتور فرانكل في كتابه (الإنسان يبحث عن المعنى) لم تكن مجرّد تعليق عابر على منظر طبيعي قد يتكرر في حياتنا عشرات أو مئات المرات؛ بل كانت فِعل مقاومة، وقفةً شامخة تشهد أن الجمال ما زال ممكنًا، وأن الحياة، رغم قسوتها، تظل جديرة بالنظر إليها بامتنان.
لم يكن مشهد الغروب في تلك اللحظة لوحةً طبيعيةً فحسب، بل نافذة على أعماق النفس؛ إذ أنه قد ينحني الجسد تحت وطأة الجوع والبرد والإذلال، ولكن الأهم أن القلب ظل قادرًا على أن يرتفع فوق الواقع ليلمس ما هو أسمى.
الجمال هنا لم يكن مجرّد لونٍ في السماء، بل شهادة على أن الإنسان يستطيع أن يحافظ على حريته الداخلية، حتى وإن سُلبت منه كل الحريات الأخرى.
الصلابة النفسية: سُمو ومَعنى
في حقيقة الأمر، يتطلّب تطوير التفكير المتمعّن في حال المعسكر الذي خاض فيه الدكتور فرانكل جزءًا من حياته، ثلاثة عناصر رئيسية: التحكم (Control)، والالتزام (Commitment) والتحدي (Challenge)، وهي ما يكوّن لُب ما نعرفه اليوم باسم “الصلابة النفسية”.
هي قدرة الإنسان على تحمّل الشدائد والتكيّف معها من خلال استشعار أن للحياة معنى يستحق أن نعيش له، وإدراك أن لنا حرية اختيار الموقف حتى في أصعب الظروف، والنظر إلى التحديات والمصاعب باعتبارها فرصة للنمو لا مجرد تهديدات تقوّض سلامنا العقلي والنفسي.
بهذا المنظور الفلسفي الإنساني، يتضح أن ما رآه فرانكل ورِفاقه في لحظة الغروب لم يكن مجرد انعكاس للضوء على الغيوم، بل انعكاسًا لقوة داخلية صلبة تحوّل المأساة إلى معنى، واللحظة العابرة إلى شهادة على إنسانية لا تُقهر.
وربما لهذا ما زالت تلك الكلمات ترنّ في آذاني حتى اليوم: «كم يمكن أن تكون الدنيا جميلة!».
أشعر أنها ليست وصفًا لسماء بافاريا فقط، بل وصفٌ لقدرة الإنسان على أن يجد الجمال في قلب القسوة، وأن يجعل من الصلابة النفسية طريقًا إلى معنى يتجاوز حدود الألم.
الألم والوجود والثقافة
وإذا كان فرانكل قد كشف في لحظة غروبٍ أنّ الألم يمكن أن يتحوّل إلى معنى يحرّر الروح، ويوجهها للتلذّذ بالجمال، فإنّ علم الاجتماع (Sociology) وعلم الإنسان (Anthropology) يضيفان أبعادًا أوسع وآفاقًا بالغة الأهمية: فالألم في جوهره الأسمى لا يُعاش في عزلة، بل يُعاد تشكيله داخل فضاء اجتماعي وثقافي محدَّد.
فهو ليس مجرد إشارات عصبية تنتقل من المستقبلات العصبية والحسية –الجلد– إلى الدماغ، بل خبرة إنسانية عميقة ومركّبة تتأثر بالرموز والمعاني والقيم التي يحملها المجتمع.
فعلى سبيل المثال، قد يجد الجندي الذي جُرح في ساحة المعركة وفقد طرفًا أو أكثر أن لآلامه لذّةً ومعنى، لأنه عاد من بين القتلى والدمار، بعد أن خدم بلده ودافع عن دينه وحمى أهله ومجتمعه. ولذا، قد يرى في حالة من التسامي أن الألم في صورته تلك مجرّد تفصيلًا ثانويًا. وفي المقابل، قد يرى شخص يستعد لعملية جراحية روتينية، كتنظيف جير الأسنان، أن الألم حدثٌ جلل يهدد حياته، فيبالغ في توقعه والشكوى منه؛ وهنا نرى بوضوح كيف يُفسَّر الألم وفق موقع الفرد وتجربته الاجتماعية.
الأمر ذاته قد ينطبق على الرياضيين المحترفين، إذ يفضّل كثير منهم كِتمان إصاباتهم عن العائلة والجماهير والإعلام، خشية أن تُفسَّر الشكوى كضعفٍ أو تقصير أو تخاذل؛ وفي هذه الحالة، لا يعود الألم مجرد إحساس جسدي فردي، بل يصبح اختبارًا للانتماء إلى ثقافة جماعية تُمجّد الصبر والتحمّل، وتمنح قيمة أسمى لـ «اللعب رغم الألم».
ومن زاوية أخرى، تكشف الاعتقادات الدينية في بعض الثقافات أنّ الألم قد يُعاش لا بوصفه نِقمة، بل كحالة من «الرِفعة» أو الاصطفاء الرمزي لعيش حياة لها معنى أسمى؛ فما كان مؤلمًا جسديًا ونفسيًا قد يتحوّل إلى تجربة جماعية من الدعاء والإنابة والتقرب إلى الخالق سبحانه، وهنا قد يصبح الألم فعل مشاركة روحية يتجاوز حدود الجسد الفردي.
والعجيب في هذا المنظور أن الألم يظهر كمسار مزدوج: من جهة يختبر صلابة الفرد وقدرته على اكتشاف معنى خاص لمعاناته، ومن جهة أخرى يعكس عمق انغراس الإنسان في ثقافته ومجتمعه، ومدى تأثيره عليها وتأثره بها، فيصبح الألم ليس مجرد امتحانًا للوجود الفردي كما رأى فرانكل وآخرون، بل أيضًا مرآة كبرى تعكس الثقافة التي نحياها، وما تمنحه لنا من أدوات لتفسير الألم وتحمّله.
ومضات في حياتنا اليومية
قد يظن البعض أن حديث فرانكل أو دراسات علم الاجتماع عن الألم تخصّ لحظات استثنائية في حياة الإنسان، لكن الحقيقة أن كل إنسان منا يمرّ بمعسكره الخاص: قلق الامتحانات، ضغط العمل، فقد عزيز، أو حتى صراعات داخلية صامتة.
وهنا يصبح استحضار المعنى والبحث عن ومضات الجمال ضرورة لا ترفًا، إذ أن ربط آلامنا الصغيرة بمقاصد أكبر: هدف نتعلم من أجله، رسالة نخدم بها غيرنا، أو قيمة نتمسك بها.
والهدف من قراءتك لهذا النص، هو أن تطور منظورًا تستطيع من خلاله أن تلتقط تفاصيل عابرة – ابتسامة صديق، كلمة شكر، مشهد غروب – وتجعلها زادًا يذكّرك بأن الإنسان ليس أسيرًا لأي ظرف، بل سيد كل المواقف التي يمر بها؛ وهذا هو جوهر الصلابة النفسية.
وعندما أتذكّر تلك الهمسة المنبعثة من قلبٍ مكسور وجسدٍ منهك في معسكرٍ نازي، أشعر أن عبارة «كم يمكن أن تكون الدنيا جميلة! » لم تكن وصفًا لسماء بافاريا، بل كانت كشفًا عن سرٍ دفين: أن الإنسان قادر على أن يرى فوق أنقاض آلامه معنى، وأن يحوّل لحظة قسوةٍ إلى شهادة على حريته الداخلية.
وهنا أجد أن الألم، بكل ما يحمله من إرث، ليس النهاية بل بدايةٌ لمعنى جديد، ومعنى يفتح نافذة على جمالٍ أبقى وأوسع، تلك التي ندرك عندها فقط أن الدنيا قد تكون أجمل مما نظن، متى ما اخترنا أن نراها كذلك.