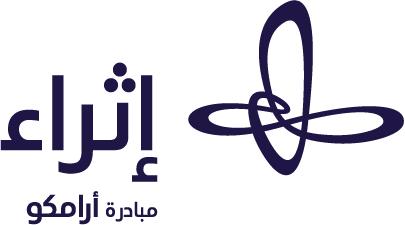«أنا أعرف كل شيء». هذه الجملة ليست إلا نَعيًا يكتبه قائلها لنفسه، ففي الحياة لا يمكن للإنسان أن يعرف الكثير، ولا يتوقف فيها الناس عن النمو، ربما جسديًا يحدث هذا، ولكن العقل أبدًا لا يتوقف عن النمو والتعلم والتغيير، وفي اللحظة التى يتوهم فيها الإنسان أنه وصل لمعرفة كاملة، أو أنّه أعلم من غيره؛ يتوقف عن الحياة. فالحياة ديناميكية مَرِنة، تفاجئنا دائمًا بتغيراتٍ ليست في الحسبان، والجمود فيها يعني السقوط في هوّة عميقة، إذ أنها تتغير كل يوم بل كل لحظة، فلماذا لا نُغيّر نحن آراءنا ونتشبث بها؟
ميكانيزمات دفاعية
حينما تصرخ الأم في وجه طفلها بقوة وتطلب منه أن يفعل شيء ما، ماذا تظنه يحدث؟ يتحوّل الطفل فورًا دون وعي منه لحالة دفاع عنيفة؛ يقفز عقله خلف حصنٍ منيع، ويرفض طلب الأم بعناد وتحفز، وهذا لأن العقل أتخذ «ميكانيزمات» دفاعية لهجومٍ مباغت، ولا يستطيع الطفل حينها التفريق بين غضب الأم؛ الذي يكرهه ويخيفه ويحبطه، وبين ما تطلبه منه وإن كان فيه خيرٌ له.
وكذلك نحن البالغون؛ الانتقاد اللاذع وتكرار الخيبات في محيطنا، يعملان بمثابة أحجار توضع فوق بعضها البعض ليتكوّن في النهاية دون أن ننتبه حِصن منيع يختبئ خلفه عقل الإنسان، وأيّ محاولة تأتي من المحيط الخارجي لتغيير الآراء أو تعديل الأفكار، يترجمها العقل على أنها هجوم وانتقاد لاذع مثل الذي اختبره من قبل، ومن ثَم يقابلها بدفاعٍ نفسي محصن، تعلَّمه منذ الصغر دون إرادة منه.
ربما يقع الإنسان ضحيةً لمحيطه وللأحداث من حوله، ولكن الوعي بما يحدث في داخل عقله نتيجة لذلك يجعله قادرًا على تحسين حالته وتطوير أفكاره؛ فمثلا حينما يصاب الإنسان بخيبة أمل في شخص يحبه، يفقد الثقة في محيطه، ويعتقد أن الخذلان سيأتيه من كل حدبٍ وصوب، فيقبع خلف حصنٍ عقلي يصد الأشخاص والأفكار الجديدة التي تأتيه من الخارج، الوعي بتلك الحالة ومعرفتها يقاوم تلك الميكانيزمات الدفاعية، ومن ثم إزالتها بالكامل والانفتاح على العالم. العقل المتفهم لحالاته النفسية عقل واعٍ، منفتح، والآخر يختبئ خلف حصون الدفاعات النفسية المتراكمة، تلك التي تمنع عنه الضوء والهواء، وتبقيه في حالة تشبث بآرائه الذاتية ورفض تام للتغيير أو التعديل على فكره.
كثيرًا ما نجد أنفسنا مضطرين للتعامل مع عقول محصنة، مغلفة بالحجارة، تتعامل مع محيطها بشكل متحفز، متشكك، ومتعصب لفكره الشخصي، مهاجمًا كل ما دون ذلك. وعلى الأغلب يميلون للتشاؤم وتوقع حدوث الأسوأ دائمًا. لتعلم أن هؤلاء ضحايا لغيرهم من أشخاص أو أحداث، ولكن لم يحسنوا فهم أنفسهم، وما يحدث في رؤوسهم، لذلك يعجزون عن التغلب على تلك الحصون العقلية التي تكونت أمام عقولهم، فتدفعهم للتعصب وتمنعهم من التحرر واستقبال خبرات جديدة.
الصور النمطية
الإنسان يرى ويسمع ويشعر بكل شيء يحدث حوله عبر المفاهيم، فالدماغ يعمل عن طريق مقارنة كل المدخلات الحسية بنماذج مسجلة بشكل مسبق، تلك النماذج تكونت عن طريق صور نمطية يتخذها العقل كمرجع لفهم الأشياء.
والصور النمطية هي اختزال للثقافة والتقاليد والجو الإجتماعي المحيط وكل الخبرات السابقة، ونحن في عصر الحداثة تتعرض عقولنا لهجومٍ دائم، فالمؤسسات والشركات لا تكف عن محاولة السيطرة على العقل عن طريق التلاعب المستمر في الصور النمطية، فمثلًا أغلب الشركات الآن تهدف لتحويل منتجاتها لنمطٍ في حياة المستهلك، حتى ينسى المستهلك أنّه كذلك ويتعامل مع المنتج لا بكونه منتجًا قابلا للاستبدال بآخر، بل كجزء من حياته. لذلك يحاولون خلق صورٍ نمطية تربط المشاعر بمنتجات استهلاكية، كالسعادة مثلًا حينما ترتبط بمنتج معين، أو حالة إنسانية كالعطش والشعور بالحر حينما تُربط بمشروب.
النمط يُبنى بشكلٍ تراكمي عن طريق الآلات الإعلامية، كما أحب أن أسميها؛ فالآلة تعمل دون كللٍ أو ملل لهدف محدد ولا تتوقف عن أداء وظيفتها، ولا تتساءل عن مدى نفع تلك الوظيفة للإنسانية.
وهذا ما تفعله الكثير من الحملات الإعلانية؛ تهاجم عقولنا دون كلل أو ملل حتى تحكم سيطرتها عليه، فتصبح الصورة النمطية شرك تقع عقولنا بداخله، فنتبنى بأقل قدر من التفكير أفكارًا صنعها غيرنا، ونحن في خضم حياةٍ تستهلك طاقاتنا على الدوام، تُشغلنا في أمورنا الشخصية بقدرٍ كبير، فنميل لاستهلاك الآراء المعلبة والجاهزة، نتبناها دون تفكير. وربما نكتشف أننا نعيش الحياة متعصبين لصورٍ نمطية خادعة، وندافع عن أفكار لم نتوقف لحظة لنسأل أنفسنا هل هي أفكارنا حقًا؟ أم وُضعت في عقولنا وضعًا.
أغلبية ساحقة، لكن إلى أين؟
في عصرنا الحديث يُروّج للأغلبية على أنها الصواب، فلا يجد الإنسان مفرًا من اتباع آراء الأغلبية، ومع التطور المذهل في منصات التواصل الإجتماعي، وبفعل ثقافة الـ (Trend)
السائدة، بات من السهل التلاعب في الوعي الجمعي للناس، فكل الناس يتحدثون عن شيء واحد ويتداولون نفس الأخبار ونفس مقاطع الفيديو القصيرة، وحينما يُسقى العقل من منبع واحد يُنتج أفكارًا موحدة، فتتشابه أغلبية الآراء إلى حد يشبه التناسخ، حينها يسهل تحريك أغلبية الناس للاختيار والاستهلاك بضغطة زر واحدة! فأيّ أغلبية تلك التي على صواب؟!
ويبدو أنه من المريح أن تسير مع القطيع، فلا تحمل هم قرار ولا تنتابك الحيرة في تحديد وجهتك، ولكن ماذا لو أن ذلك القطيع يتخذون الهاوية وجهة لهم؟
«إلى أين؟» هذا هو السؤال الأهم، والذي على الأغلب سيضرب بأفكار الأغلبية عرض الحائط، وفي النهاية كل فردٍ مسؤول عن ذاته، لذلك لا يجب أن يدخر الإنسان أي جهد في سبيل تنمية أفكاره، تغييرها، تنضيدها بشكل مستمر، وألا يتشبث برأيٍ ما فقط لأن الأغلبية تبنته! أنت هو أنت، وكل صفٍ تتخذه يحدد مصيرك الشخصي ويمس حياتك بشكل مباشر.
فوبيا النصائح
أكاد أجزم ألا أحد في هذه الأيام يُحب أن يتلقى النصائح، الناس يلوذون بالفرار ويغلقون آذانهم فور أن يستشعروا أن أحدًا ما يوجه لهم النصيحة! وهذا نتيجة الاستخدام الخاطئ للنصائح؛ حيث بات يستخدمها المتعالون لتأكيد تعاليهم، والحاقدون للتشفي وقت وقوع المصيبة، يستخدمها أيضًا المهووسون بالسيطرة لصد الأفكار والتلاعب بعقول الغير. هذا الاستخدام الواسع والخاطئ للنصائح أبعد الناس عنها، وباتت واحدة من أهم الخصال الإنسانية النبيلة معرضة لخطر الإنقراض.
في حقيقة الأمر الإنسان في حاجة دائمة للنصائح، تلك التي تأتي في وقتها من شخصٍ أمين، فتعمل كقنديلٍ يشتت الظلام وقت حلوله ويضيء لنا الطريق حينما نُضيّعه، النصائح تطور من أفكارنا وتحسنها، تحمينا من مغبة التعصب لآراء خاطئة، وتزيد من جودة أدائنا على كافة الأصعدة في الحياة. والناصح الأمين يجب أبدًا ألا تفقده إذا كان موجودًا في حياتك، فالإنسان تأتي عليه أوقات يحتاج فيه لأي نصيحة، حتى لو كانت بديهية ومعروفة، فنحن في خِضم معاركنا اليومية ننسى كيف يمكننا التغلب على مخاوفنا، ويذكرنا بذلك القريبون من قلوبنا عبر نصيحة لطيفة تربت على القلب. التعصب ورفض النصائح بشكل عام يجمد عقولنا ويزيد نسبة وقوعنا في الخطأ.
يقول سيدنا صالح عليه السلام لقومه في الآية الكريمة: «ونصحتُ لكم ولكن لا تُحِبُّون النَّٰاصحين» وهذا حينما لم يسمعوا نصيحته وعقروا الناقة، فذاقوا عاقبة مريعة لإستكبارهم عن النصيحة.
أين المفر؟
ماذا يسعنا أن نفعل إذًا؟ لا يجب أن نتشبث بآرائنا وأفكارنا ونتعصب لها، وفي نفس الوقت التضليل والأفكار الفاسدة تحاصرنا من كل اتجاه، يبدو الأمر كأحجية يصعب حلها، ولكن تعلمت أن الأمور التي تبدو معقدة حلها بسيطٌ للغاية.
الحل يكمن في الحفاظ على فطرتك الإنسانية السليمة التي خلقنا الله بها، عقيدتك التي تجعلك تؤمن بالخير وترفض الشر، التمسك بالأبيض والأسود، ورفض السقوط في تلك المساحات الرمادية الواسعة، فالشر دائمًا يحاول حصر الاختيار بين الرمادي والأسود، وحينما تختار الرمادي تنصر بذلك الشر.
ختامًا يقول برتراند راسل: «الأفضل من أن تكون حريصًا أن تكون نقيًا في قلبك» وهذا في نهاية مقالةٍ له عن الأسرة ذهب فيها لحدود بعيدة في عرض المشكلات التي يتسبب فيها الآباء للأبناء والاشتراطات التي يجب أن يتبعوها، وبعد تعقيدات كثيرة خلص لتلك النتيجة المريحة.
بكل بساطة؛ نقاء القلب يقودك للطريق القويم نحو الخير دائمًا، وتذكر أنّ الفِكر الصحيح كرافدٍ تتحرك فيه المياه بشكل مستمر، وإذا توقفت حركة المياه أصبح مستنقعًا فاسدًا. التعصب والتشبث الأعمى بآرائنا يخلق حالة من الجمود تعمل على تحويل العقل لذلك المستنقع الفاسد.