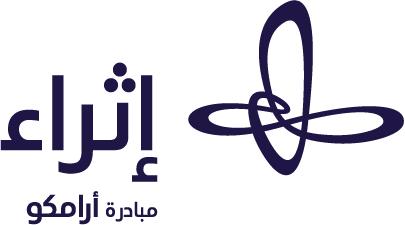لا شيء نخاف منه في حياتنا الحديثة أكثر من الوقوع في الحب، ولا شيء نطلبه ونبحث عنه ونرغب فيه أكثر من الحب! نريده ونخافه، نبحث عنه ولا نفهمه. وفي عصرنا الحديث يبدو أن الحب يغادرنا، نسيء فهمه ويسيء فهمنا، فلماذا لا نفهم الحب!؟ رغم كل هذا التقدم والتطور، والاكتشافات النفسية المذهلة!
ما الحب!؟
الخطأ في الحب يبدأ من الخطأ في تعريفه، ومن ثم تأويله وتجريده من المعنى الحقيقي له، وما أكثر الخطأ في التسمية والتعريف في عالمنا الحديث؛ لا سيما تلك المفاهيم التي يكثر الحديث عنها دون وعي، فدائما ما يكون الخطأ حليفًا للابتذال.
الحب شعورٌ يميل للمطلق، فهو غير محكوم بقاعدة ثابتة أو تعريف محدد، وأن كل محاولة لتحديد الحب وتعريفه، ووضعه في إطار وربطه بنموذج إنما هي محاولة لاختلاق الحب وتزييفه، فهو غامض بطبعه، غير مفهوم، وليس من المفترض أن يُفهم، لا مبرر واضح له، ولا يجب أن يكون مُبررًا، فالحب بصمة قلبية، تختلف من إنسان لآخر، أي من قلب لآخر.
وإذا ما أردنا تعريف الحب دون خنقه واختلاقه، فهو قبول لخوض المجازفات والمتاعب، وتقبل لعدم الاستقرار الناتج عن التعامل مع المجهول، الحب قبول لهذا المجهول في سبيل بناء علاقة مع ذات أخرى، وهذا البناء إنما يُبنى من مجهول ويواجه المجهول طيلة الوقت؛ يواجه المستقبل بما يحتويه من متغيرات لا يمكن توقعها، فلا يمكن توقع مآل الحب، ولا استباقه ولا اجتنابه.
نحن لا نفهم الحب، لأننا لا نريد أن نفهمه بمعناه الحقيقي؛ المتطلب والمشروط والصعب، والذي يحتاج لمجهود والتزام، فنحن نعيش في عصر السطحية، والسعي المحموم خلف الأشياء التي يسهل تناولها ويسهل أيضا التخلص منها إذا ما أردنا.
فحينما يكون الأساس الفكري الحديث قائمًا على التخلص التام من المسؤوليات، والتخفف من عبء العلاقات الإنسانية الحقيقية، والبحث الدائم عن المتع اللحظية، تلك التي نُستهلك فيها ونستهلكها، وإذا ما انقضت سريعا، بحثنا بسرعة أكبر عن غيرها، ستكون النتيجة الحتمية هي العمى عن رؤية الحب الحقيقي وفهمه، وربما عن أي حقيقة أخرى؛ حقيقتنا وحقيقة الحياة التي تلائمنا.
الحب وتعاظم الأنا!
في عالمنا الحديث أصبحت الذات هي المركز، لأن نمط الحياة في عصر ما بعد الحداثة يدفعنا عنوة للتمركز حول ذاتنا عبر تهميش الآخر، بل واختزال وجوده في خدمتنا وتحقيق ما نريده منه وفقط. وهذا الاتجاه الذي يعزز الأنانية، ويدفع الإنسان الحديث للإمعان في حب الذات، وتقديسها، إنما ينتج عنه بشر محاطون بشظايا زجاجية حادة، تجرح كل من يقترب، دون إرادة أو اختيار!
نرى الآن في الإعلانات والأغاني وحتى في الكتب حالة من الإغراق في مدح الفردانية، فهذا الربط الممنهج بين قدرة الإنسان في تخطي مشكلاته وآلامه وبين تعظيم الذات وتغذية الغرور الشخصي، إنما هو مكمن المأساة، فإذا رأى كل إنسان في نفسه قيمة عظمى لا يمكن خسارتها، وإذا توهم استحقاقه للأفضل بشكل دائم، ستصبح الفضيلة في الأخذ دون عطاء، وطلب المستحيل دون عناء، وهذا ببساطة يعني موت الحب! بل وتضرر جزء كبير من إنسانيتنا.
وهنا يقول زيجمونت باومان: “الحب يعني توق لتوفير الحماية والإطعام والإيواء، والملاطفة والتدليل، إن الحب يعني أن يكون المرء في خدمة الآخر، وتحت طلبه، ورهن إشارته، إنه السيادة عبر الاستسلام، فالحب توأم ملتصق للتسلط ولا حياة لأحدهما إذا انفصلا”
إذن الحب الحقيقي إنكار لتلك الفردية التي يتسم بها عصرنا الحديث، فهو يخرج المرء من ذاته ويقحمه في الآخر، إنه شعور يعاكس التيار، حيث يدفع الإنسان بعيدا عن المركز.
نحن نخطئ فهم الحب، لأننا نعتنق أسلوب حياة يعاديه ويخنقه، فتعاظم الأنا إنما يُعمي الأبصار، ويفسد العلاقات، ويبعد الإنسان عن معنى الحب الحقيقي، فالذات الراسخة، تميل للعطاء، ولا تحتاج لوهم الغرور حتى تثبت وجودها.
نحن لا نفهم الحب الحقيقي، لأننا أردناه حبًا عجيبًا، يخلو من أي التزام أو تنازل، أردناه حبًا أنانيًا، يتمحور حول ذاتنا، ولا نرى فيه الآخر، وأي مساس بالمتعة الدائمة، أو انتقاص من المنفعة الكاملة، يكون الخيار الوحيد والمباشر هو ترك كل شيء والمغادرة فورا!
البحر والحب
تخيل معي بحر أمواجه متلاطمة، تهدأ تارة، وتعصف تارة أخرى، ووسط ظلمة هذا البحر، واضطراب أمواجه، يطفو قارب خشبي صغير، لا يتسع إلا لاثنين وفقط، فهما يواجهان الأمواج وخطر الغرق عبر قارب صغير، إذا استقر لا يتوقف عن الاهتزاز وإذا اضطرب كاد أن يغرق.
الحب مثل هذا القارب الخشبي الصغير الذي لا يتسع سوى لشخصين، يبحران معًا في الظلام وسط أمواجٍ كاسرة ورياح تقلب الموازيين.
هذه طبيعة البيئة التي ينمو فيها الحب، وأيّ محاولة لتخليص الحب من قلقه هي محض وهم أو تزييف، فالقلق هنا ويا للعجب أمر صحي بل شرط أساسي في الحب الحقيقي، حيث إن هذا القلق إنما يدفع الإنسان للعطاء والعمل الجاد المستمر لإنجاح هذا الإبحار، فكلما تعالت الأمواج التي تهدد قارب الحب، تعاظمت قيمة الأنس بين الحبيبين. لذلك الحب استعداد لمواجهة الصعاب والمحن، والإبحار في بيئته غير المستقرة وأن توقع غير ذلك، إنما هو تسريع للغرق، فما أكثر راكبي القوارب، وما أكثر الغرقى!
يقول إريك فروم في كتاب فن الحب: “لا يمكن تحقيق الحب من دون شجاعة حقيقية، وإيمان حقيقي، وتواضع حقيقي، وانضباط حقيقي”
فالإبحار يتطلب الشجاعة، وإلا سيقفز الربان من القارب مع أول صفعة موج أو هبة ريح! وإذا ما كان تعريف الحب كما ذكرناه آنفًا قبول للمجازفة، كانت الشجاعة شرطًا أساسيًا لبناء علاقة متكاملة، متزنة، والأهم مستمرة.
والإيمان ضروري من أجل التمسك بالحب حينما تعصف الأجواء وترعد، وأما التواضع فهو ما يتيح للإنسان تقبل الاندماج مع الآخر في ذات جديدة تتسع لاثنين لا لشخص واحد فقط، ويأتي أخيرًا الانضباط من أجل التمسك بكل ما سبق، ولأن الحب رغبة في العطاء، يأتي الانضباط من أجل الثبات على هذا العطاء، والعطاء في الحب لا يقتصر على بذل المادة وفقط، إنما يكون عطاء منفتح لكل ما يحتاجه الآخر؛ من مشاعر، ومؤانسة، ومؤازرة وقت المحن، وأسمى أنواع العطاء في الحب، هو تبادل الصدق.
ولا شيء يحقق كل تلك الشروط في خطوة واحدة مثل إرجاع التعامل بين الحبيبين لحكمة مقدسة، واسعة، تتسع لكل البشر وتحكم أمورهم، وتقيّد نوازعهم إذا ما أرادوا بها التدمير والإفساد، وهي حكمة الله، خالق هذا الكون ومدبر أمره. بهذا يبحر قارب الحب بسلام، وينجح في عبور العواصف والأعاصير، فمنتهى الحب هو الاستمرار في الإبحار، لأن الحب الحقيقي لا وجهة نهائية يمكن أن يصلها.
تذكر دائمًا – قارئي العزيز- أن القارب المتأرجح دليل على صحة الحُب، فالقوارب تسكن فقط إذا كان البحر مزيفا، والإبحار في بحر حقيقي، على خطورته هو أشد متعة من الإبحار في بحيرة راكدة، ومع سمو الهدف وبهذا الاضطراب وتلك الخطورة، يتحقق معنى الإبحار.