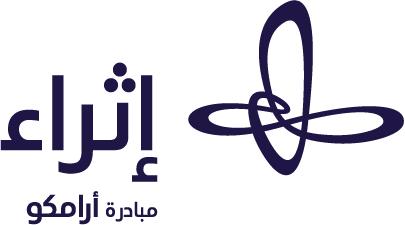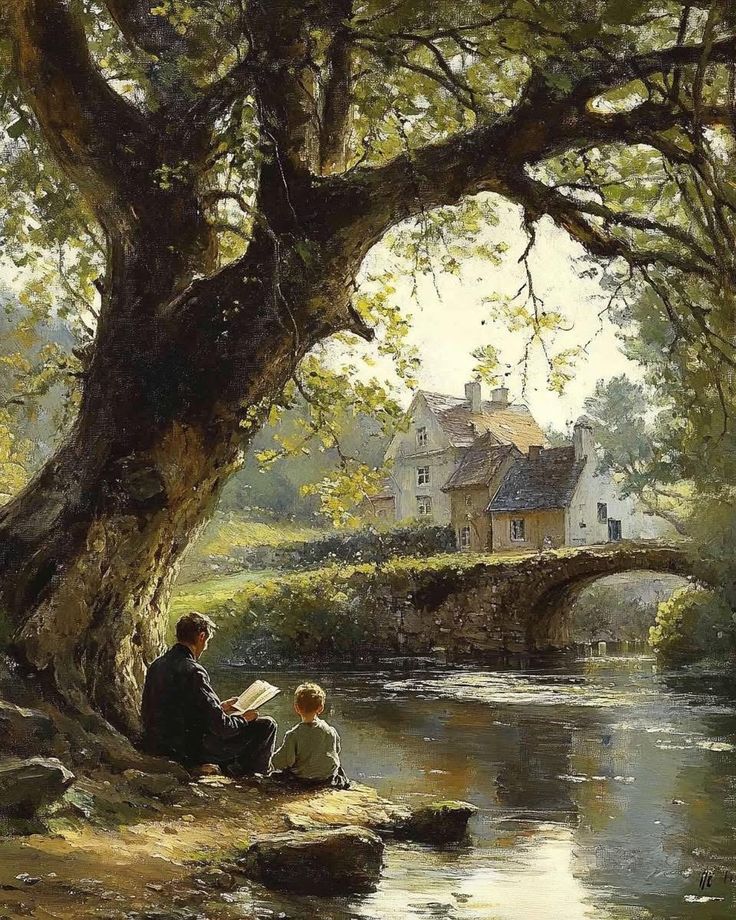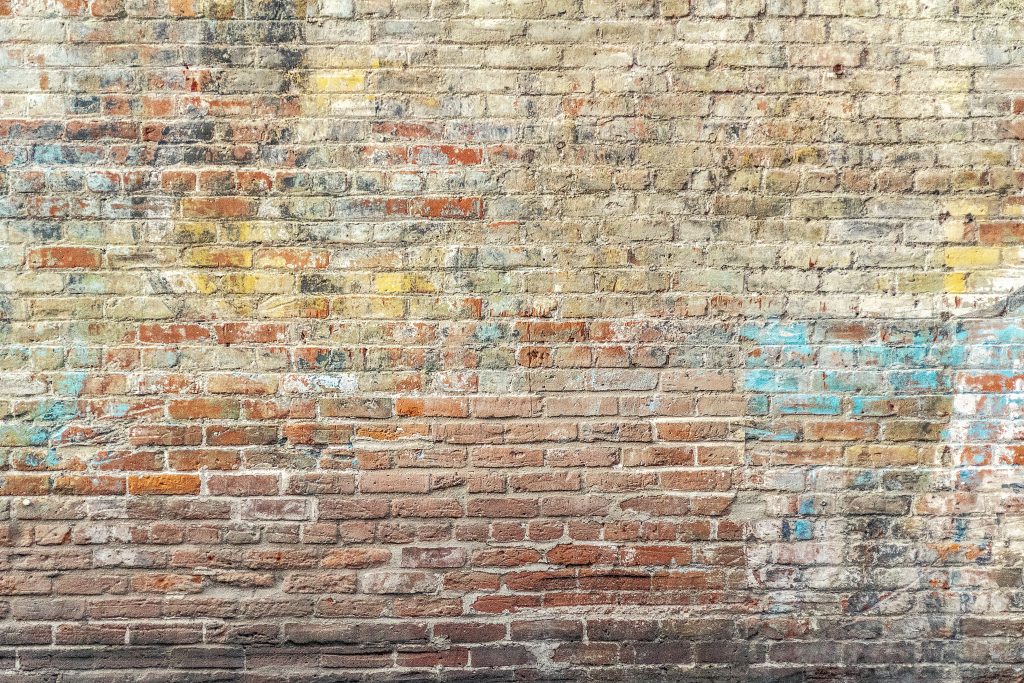في اللحظة التي تضع فيها قدمك على عتبة باب المول التجاريّ، فإنّك تنفصل تمامًا عن العالم الخارجيّ. أنت لست أنت، ولا الوقت هو الزمن نفسه الذي نحرص عليه ونرتبط به، ونبرمج خططنا ومواعيدنا على إثره. مدخل المول هو في الحقيقة أشبه ببوابة مغارة علي بابا، كلاهما يقودانك نحو عالم آخر شبيه بمتاهة، تشعر أنّه يبتلعك ويجترف أحاسيسك بشكل أهوج ومتسارع، وأنّ عجلة الزمن تتوقف بمجرّد دخولك إليهما. الفرق الوحيد هو أنّك داخل المغارة -ربما- ستعثر على كنوزٍ لا حدّ لها، أما داخل المول فستنفق أموالًا لا حصر لها.
المول مدينةٌ داخل مدينة
المول فضاء قائم بحدّ ذاته، لا يشبه شيئًا إلَّا نفسه، ولا ينتمي إلى المدينة التي يكون فيها، بل هو مدينةٌ مشيّدة داخل مدينة، يحوي كلّ عنصر يمكن أن يتجمع ليشكل هذا المفهوم: المحلات التجارية، والمطاعم، والمكاتب، ودور السينما ومواقف السيارات، وأماكن الصلاة، ودور المياه وغيرها، في محاولة لإيحاء الزائر بشعور الانتماء والأمان الذي يرافق الإنسان في بيته، أو مدينته.
لكنّ مدينة المول في الحقيقة مفتقدة إلى الهويّة، تفتقر إلى الخصوصية، وهي واحدة من اللاأمكنة التي تحدّث عنها الفيلسوف الفرنسيّ “مارك أوجيه” بأنها تشعر الفرد باللاهويّة وتجعله يفتقر إلى الانتماء. المول هو المول، الهندسة ذاتها في كل مكان، في أمريكا أو الفلبين أو المغرب، جميعها لا تهتمّ لانتمائك ولا راحتك -كما تزعم- بقدر ما تهدف للتأثير عليك بشكل خفيّ يدفعك إلى الاستهلاك والإنفاق.
ظهر مفهوم المول لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، يقول المؤرخ الأمريكيّ كينيث تي جاكسون: “المصريون لديهم الأهرامات، والصينيون لديهم سور عظيم، والإيطاليون لديهم قلاع عملاقة، أما الأمريكيون فلديهم مراكز تسوق”؛ إذ يعتبر مركز ساوثديل التجاري في مينيسوتا هو أول مركز يتم افتتاحه بالمفهوم الحديث للمول. وكانت دعايته التجارية تشجع على الاستهلاك بشكل واضح وصريح: “كل يومٍ سيكون يومًا ممتازًا للتسوق في ساوثديل”، وبالفعل، وبحلول سبعينيات القرن العشرين، قُدّر بأنّ الأمريكيين يقضون وقتًا طويلًا جدًّا في المول، أكثر مما يقضونه في أماكن العمل أو المنازل.
انتقلت عدوى المولات التجارية من أمريكا إلى العالم مع موجة ما يعرف بالعولمة، وشيئًا فشيئًا أصبحت المولات بديلًا عن المنازل والحدائق، والجبال وكل ما يمتّ للطبيعة بصلة. صارت هي المكان الرئيسي للقاء، واجتماعات العمل والترفيه، وحتى حفلات الزفاف والعزائم، كما أصبحت الفضاء الأمثل لقضاء أوقات الفراغ والتجمع حتى لأولئك الذين يملكون دخلًا منخفضًا أو لا يقدرون على الإنفاق. المشي داخل المول يمنحهم شعورًا موهومًا بالتملّك، يشعرهم بالرضى الذاتيّ.
غيّرت المولات التجارية -كذلك- مفهوم الروابط الاجتماعية، وأثّرت فيها بشكل سلبيّ. الرحلة العائلية التي تكون فرصةً لتسلق الجبال أو الاستمتاع بالطبيعة أو زيارة الواحات، أصبحت رحلة تسوقية استهلاكية بالدرجة الأولى، واللقاءات التي كان من المفترض أن تعزّز التواصل والتفاعل بين العائلة والأصدقاء، صارت مجرّد تسوّق جماعيّ.
المولات نقلت الإنسان من حيّز الجماعة والآخر إلى الحيّز الفرديّ الذي لا يعنيه شيء سوى ما يمتلكه، ويشتريه ويستفيد من عروض تخفيضاته. وهذا ما تراه أستاذة علم الاجتماع بكلية بوسطن “جولييت شور” في كتابها “ولدت لتشتري: الطفل التجاري وثقافة الاستهلاك الجديدة” أنّ المولات تخلق في الحقيقة مجتمعات قائمة على الاستهلاك لا على التواصل الحقيقي.
لقد كانت الأسواق التقليديّة في السابق فرصةً لتبادل المعارف والخبرات. أسواق الآغورا في اليونان كانت محضن الفلاسفة والمفكّرين، وساحة للنقاشات والآراء، وأسواق العرب كعكاظ كانت أشبه بمعرض أدبيّ فنّي تُجْرَى فيه المساجلاتُ، وتُلقى فيه أعظم الأبيات الشعريّة، ويُعرف فيه شعراء القبائل العربيّة. المولات الآن قضت على كلّ مظهرٍ للتشارك وتبادل المنافع والتفاعل، لأنّ الشيء الوحيد المهم بالنسبة لها هو سير عجلة الإنتاج.
في المول أنت تستهلكُ رغمًا عن أنفك
تأسّست المولات والمراكز التجارية وفق شعارٍ واضح وصريح: Shop till you drop – تسوّق حتى تسقط من التعب، ومع تطور تقنيات التسويق والتأثير، أصبحت تتلاعب بالمستهلك بمختلف التفاصيل والطرق لتدفعه إلى الاستهلاك بشكل أكبر. كم هو عدد المرّات التي نويت فيها دخول المول لشراء غرض تحتاجه ورجعت إلى المنزل بأغراض أخرى لم تضعها أبدًا في الحسبان؟ لا شكّ أنّ الأمر حدث معك عشرات المرّات، وقد حدث معي كذلك.
يقول المفكّر المصريّ “عبد الوهاب المسيريّ”: “نحن نعيش في عالم يحولنا إلى أشياء مادية ومساحات لا تتجاوز عالم الحواس الخمس” وهذه الحواس هي في الحقيقة ما يتمّ استهدافه في المول لدفعك إلى الاستهلاك. بدايةً من الصوت، الضوء، الموسيقى، والرائحة، لا شيء يوضع مصادفةً هنا، بل يتمّ اختياره وفق خطّة تسويقية محكمة تهدف إلى إبقائك بشكلٍ أكبر داخل المول.
فور دخولك، ستُبهر بكمية الإضاءة الساطعة المتواجدة في المركز، والموزعة على المحالّ واللاّفتات، سيخطف بصرك ذلك التوزيع السّريع والقوي لها، بعضها مركّز بشكل كبير على منتج أو لباس معيّن، ليشعرك بجماله ويوهمك بضرورة اقتنائه، وحين تفعل ذلك وترجع إلى البيت ستفاجأ بأن ذلك اللباس لم يكن -ربما- بتلك الروعة التي تصورتها في المركز. في أماكن أخرى مثل المقاهي، والمكتبات، الإضاءة تكون خافتة، لتمنحك شعورًا بالدفء والسكينة والاطمئنان، وتجعلك تقضي وقتا أطول وربما تطلب أشياء أكثر.
الأمر ذاته ينطبق على الموسيقى. الريتم المتباين بين السريع والبطيء لا يُختار عبثًا. الموسيقى الهادئة الكلاسيكية التي تصادفها في محلّات الملابس تريد في الحقيقة أن تشعرك بالاسترخاء لتبقيك في المحلّ لوقت أطول. والمحلّ ذاته يلجأ إلى استعمال موسيقى صاخبة وسريعة في أوقات التخفيضات والعطل، لأنّ عدد المشترين يكون كبيرًا وقد يكون المتجر مكتظًّا، والموسيقى الصاخبة تحثك على المشي وعدم البقاء أمام المنتج لمدة طويلة حتّى يتسنّى للجميع رؤيته.
أما رائحة جوز الهند التي شممتها خلال فصل الصيف في محلٍّ يعرض مستلزمات الشاطئ، فهي الأخرى لم تكن مصادفة. الروائح والموسيقى والإضاءة كلها محفّزات تستهدف المراكز العصبية، خاصةً تلك المرتبطة بالدوبامين لضخّ شعور بالسّعادة والمكافأة والشروع في الاستهلاك، وقد يصل هذا الشعور حدّ الإدمان، وتعرف هذه الظاهرة باسم “اضطراب التسوق القهري – Buying Shopping Disorder” BDS
هندسة المول أشبه بالمتاهة. تجد نفسك تمشي لمسافات طويلة، ولا تدري إلى أين تريد الذهاب بالضبط، وتشعر بنسيان المداخل والمخارج رغم زيارتك له للمرة الألف. صدقني هذا الشعور بالتشوش مقصودٌ كذلك، لأنك خلال الطريق الذي تقطعه ستصادف مئات الإعلانات الترويجية، والتخفيضات والسّلع والمنتجات. ثمّ ألم تتساءل يومًا لماذا توجد المطاعم في الطابق العلوي؟ الطعام هو غالب ما يزور الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية المول التجاري من أجله، لكنّه يوضع في مكان بعيد نسبيًّا حتى تُضخّ بمدخلات كثيرة جدًّا من الإعلانات والمنتجات، منذ لحظة دخولك، حتى وصولك إلى الطابق العلوي. ثم يتكرر الأمر ذاته عند عودتك.
ألم تلاحظ كذلك بأنّ المولات التجارية تخلو من السّاعات؟ الهدف فعليًّا هو أن تنفصل انفصالًا تامًّا عن بيئتك وزمنك، أن تقضي ساعاتٍ طوال دون أن تشعر، أن تكون في سوق مغلقة، في معزل عن الزمن والبرد والحرّ والمطر، وتتفقّد السلع في كلّ الأوقات والظروف مهما كانت تقلبات الجوّ، ليلًا أو نهارًا، وهذا أخلّ حتى بنظامنا الحياتيّ، وبقاعدة “وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)- النبأ”، وأصبح من الصعب الفصل بين ساعات الليل والنهار، لأنّ كل شيء متاح وممكن في أيّ وقت.
لقد حوّلت المولات التجارية فعل التسوّق إلى تجربة تحثّ على الاستهلاك الشره دون توقف، بل وجعلت منه فعلًا ترفيهيًّا يحسّن المزاج، ويقضي على الاكتئاب، لكنّ الوعي بما تحدثه آلياته التسويقية في العقل الباطن هو الذي يجعلنا نستهلك بشكل معقول ومنطقيّ، ونلجأ إلى الحلول المستدامة التي ترفق بنا وبطبيعتنا.