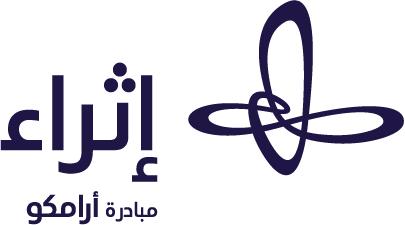حين نشرع في قراءة رواية، نكون أمام عملٍ واسع ومجهودٍ متكامل صاغه كاتب أرهقته ساعات طويلة في تحويل أفكاره الصاخبة إلى كلمات تنبض بقريحته، وتتشكل وفق أنماط لغوية تشبهه وتعبّر عن مزاجه وسلوكه وقراءاته. فأنت، بوصفك قارئًا، تستطيع أن تتعرّف إلى الكاتب من خلال نبرته السردية، ومفرداته المتكررة، وطرائق تشكيله لجمله. هذا هو صوته الإبداعي، بصمته التي قد تتبدل وتتطوّر مع الزمن، لكنها تتطوّر كما ينمو الكائن الحيّ: تدريجيًا، ببطءٍ عميق، ومن خلال طبقات متراكمة من التجربة.
وفي النهاية، تعرف أن الرواية صادرة عن قريحة الكاتب الفلاني، وأن صوته حاضر فيها حضورًا لا ينازعه شيء. فحين يقدّم الكاتب عملًا أدبيًا، فإن نبرته الخاصة تتداخل مع الأحداث سواء كانت مختلقة أو مستمدة من حياته لتتحول إلى خلاصة تجاربه ورؤيته وفلسفته التي يتبناها ويؤمن بجدواها.
لكن ماذا لو انحرف الكاتب قليلًا عن مساره المألوف؟ ماذا لو أضاف إلى فصول روايته صوتًا غريبًا عنها، صوتًا لا ينتمي إلى نبرته ولا إلى مفرداته؟ فصلٌ كُتب آليًا، لا تشبه لغته طبائع الكاتب ولا صناعته. هل يمكن آنذاك إدراج هذا الإدخال بوصفه توسعًا إبداعيًا جديدًا؟ أم أننا نكون أمام كلمات منتهَكة، مسروقة من غير روح، لا تحمل ختم التجربة ولا أثر اليد التي اعتدناها؟
هذا السؤال يفتح بابًا على جوهر العلاقة بين الإبداع والآلة، بين ما ينبع من الوعي البشري وما يُصاغ عبر أدوات خارجة عنه. ومن هنا يبدأ القلق الحقيقي: أين يقف صوت الكاتب حين يدخل صوتٌ آخر لا يشبهه؟ وهل يظل النص نصًا أصيلًا، أم يتحول إلى خليط مشوّش بين قريحة الإنسان وبرودة الآلة؟
مُنحت إحدى أرفع الجوائز الأدبية في اليابان لرواية لم تُكتب بيدٍ بشرية خالصة، بل تسلّل إلى بنائها خيط من خيوط الآلة. خمسة بالمائة فقط، كما تقول الكاتبة ري كودان، لكن هذا الرقم الضئيل يكفي لنسف سؤال عميق: إلى من تنتمي الرواية حقًا؟ للكاتب، أم للآلة التي صاغت جُمَلًا لا تحمل ذاكرة ولا ألمًا ولا تجربة؟
خلال حفل جائزة أكوتاغاوا، أعلنت كودان بلا تردد أنها استخدمت ChatGPT في كتابة روايتها “برج طوكيو للتعاطف”، رواية وصفها المحكّمون بأنها “خالية من العيوب”. لكن هل يُعدّ غياب العيوب معيارًا فنيًا، أم علامة على نص صُقل آليًا حتى فقد خشونة الروح وندوب التجربة؟
الرواية نفسها تدور في طوكيو مستقبلية، حول مهندسة معمارية تبني مركزًا لإعادة تأهيل المجرمين، لكنها تعجز عن إعادة تأهيل أحكامها المسبقة. المفارقة أن الكاتبة استعانت بالآلة لمحاكاة ما سمّته “الكلمات الناعمة والغامضة” التي تربك مفهوم العدالة. لكن هنا يطلّ سؤال أكبر وأكثر قلقًا: هل يحق للكاتب أن يستعير غموض العدالة من خوارزمية؟
تقول كودان إنها اقتبست حرفيًا ما ولّده الذكاء الاصطناعي. وكأننا أمام اعترافٍ بأن الكاتب لم يعد منشئ النص الوحيد، بل مُنسّقًا يختار من إنتاج آلة لا تعرف معنى العدالة ولا معنى الإبداع، لكنها تتقن محاكاة نبرة البشر.
وفي زمن اتّسعت فيه الكلمات بلا حدود، كما تقول كودان، هل يعني هذا أن الكاتب بات عاجزًا عن السيطرة على لغته، فلجأ إلى الآلة ليعيد تشكيل المعنى؟ وإن كان الأمر كذلك، فما الذي يبقى من الكاتب؟ ما الذي يبقى من “القريحة” إذا كان جزء من النص مكتوبًا بوعيٍ لا يعرف الوعي؟
المحكّمون رأوا العمل “يصعب العثور على عيوبه”. ولكن هل هذا الثناء هو شهادة تقدير لرؤية الكاتبة، أم إعلان غير مباشر بأن النصوص الهجينة البشرية الآلية أصبحت تنتمي إلى مستوى من الإتقان يفوق قدرة الإنسان وحده؟ وهل “النص بلا عيوب” هو نص أكثر إنسانية، أم أكثر آلية؟
تأمل كودان أن تُبقي “علاقة جيدة” مع الذكاء الاصطناعي. عبارة تبدو بريئة، لكنها تثير سؤالًا مخيفًا: هل دخلنا زمنًا يصبح فيه الإبداع عقد شراكة بين إنسان ولغة لا تُفكّر؟ وهل سيكون على القارئ لاحقًا أن يسأل: هل هذا الصوت الذي أسمعه صوت الكاتب، أم صدى آلة تتقن التقليد؟
هنا، في هذه اللحظة، تتكشّف الأزمة: إذا اختلطت روح الكاتب ببرود الخوارزمية، فهل يمكن للنص أن يحتفظ بأصالته؟ أم أننا أمام بداية عصر تُستبدل فيه التجربة الحيّة بمنتج لغوي مُحكم، لكنه بلا قلب؟
أسئلة لا تُطمئن أحدًا، لكنها تضعنا أمام حقيقة لا فرار منها: الإبداع يدخل مرحلة جديدة لا يعرف فيها أحد، حتى الآن، من هو الكاتب ومن هو الظل.
في الأشهر الأخيرة، خرجت كاتبتان من مجال الرومانسية إلى العلن للدفاع عن استخدامهما للذكاء الاصطناعي، بعد أن اكتشف القرّاء وجود آثار لغوية تُشبه ملاحظات برامج الكتابة الآلية داخل نصوص منشورة تحمل اسميهما. وبينما عبّر جمهورُهما عن خيبة واضحة، أصرتا على أن هذا لا يمسّ حرفيتهما ولا ينتقص من جهد الكاتب بوصفه صانعًا للرؤية لا منتجًا حرفيًا لكل جملة.
بدأ الجدل حين انتشرت مقتطفات من روايات ك. س. كراون ولينا ماكدونالد على منصات القرّاء، حيث لاحظ المتابعون وجود تعليقات تحريرية تشبه صياغات ChatGPT، أو نصائح تُقارب أسلوب مؤلفين آخرين كأنها جرى لصقها مباشرة في المتن الروائي. إحدى الفقرات وضعت القرّاء أمام جملة لا تخطئها العين: “لقد أعدتُ كتابة الفقرة لتتماشى أكثر مع أسلوب ج. بري…”— ملاحظة تحريرية كان يُفترض أن تبقى خارج النص، لكنها خرجت إلى الضوء كعطب يكشف اليد الخفية التي أعادت تشكيل العمل.
ماكدونالد بادرت إلى مواجهة الأمر بإدراجه صراحة في فقرة “نبذة عن الكاتبة” على أمازون، مؤكدة أنها استعانت بالذكاء الاصطناعي في صياغة بعض الأجزاء لغياب القدرة المالية على توظيف محرر محترف. وبررت اختيارها بكونها أمًا ومعلمة لا تملك رفاهية الوقت أو الميزانية، وأن استخدامها للمحرّك كان وسيلة لصقل الكتابة لا للتحايل على القارئ. هكذا وُضعت المسألة في ميزان أخلاقي مُرتبك: هل يُعدّ هذا “عصفًا ذهنيًا غير مُؤذٍ” أم “خداعًا مباشرًا”؟ وهل يُقاس الإبداع بالنوايا أم بالنتيجة التي تصل للقارئ؟
القضية لم تتوقف هنا. كراون، التي أصدرت في يناير رواية بعنوان “الهوس المظلم”، واجهت موجة مماثلة بعد أن تداول القرّاء لقطة شاشة تتضمن محفّزًا آليًا في منتصف صفحة من روايتها، يعرض “نسخة محسّنة” لجملة ويقترح زيادة الارتباط العاطفي وإضافة لمسة فكاهية. هذا الظهور الفجّ لجملة لا تنتمي إلى عالم الرواية، بل إلى غرفة محرّك لغوي، فجّر سؤالًا أوسع: هل النص الروائي ما يزال يُكتب داخل حدود المخيلة، أم بات يمر عبر طبقات تقنية تُعيد تشكيل الصوت والخيال والمعنى؟
ردّت كراون عبر حساب مساعدتها في فيسبوك، موضحة أن ما حدث كان نتاج خطأ بشري: رفع ملف مسودة يتضمن موجّهًا آليًا بدل النسخة النهائية. وفي رسالة لاحقة إلى جدل، اعترفت بالخطأ لكنها أكدت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها محدود ويقتصر على تجاوزه “عائق الكتابة” أو توليد أفكار أولية. “كل قصة أنشرها هي ملكي”، تقول. “أنا لا أستسلم للآلة، بل أستخدمها فقط بقدر ما يساعدني على تحسين حرفيتي”.
ومع ذلك، تبقى هذه التبريرات، مهما حسنت نيتها، قادرة على ختم التساؤلات الجدلية: هل يدخل الذكاء الاصطناعي هنا بوصفه أداة خلفية، أم أنه بدأ يتحول بهدوء إلى شريك خفي يعيد تشكيل النصوص؟ وهل ما يزال القارئ قادرًا على التمييز بين صوت الكاتب وصدى الخوارزمية التي تعمل تحت الصفحة؟
هذه الحوادث الصغيرة الظاهر، الكبيرة الدلالة، تُغذّي الجدل المتصاعد حول زحف الذكاء الاصطناعي إلى المناطق التي طالما وُصفت بأنها “ملاذ الإبداع الخالص”. فمجال النشر، رغم عراقة تقاليده، يمرّ اليوم بحالة تردد متناقضة: دار نشر بنغوين راندوم هاوس، كغيرها من المؤسسات الكبرى، تؤكد التزامها بحماية الملكية الفكرية ورفع شأن الإبداع البشري، لكنها في الوقت نفسه تعلن بلا مواربة أنها ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المولّد. وكأن الصناعة بأكملها تقف على حافة مفترق: ترفض الآلة نظريًا، وتتبناها عمليًا.
عندما نقترب من مواقف دور النشر الكبرى تجاه الذكاء الاصطناعي، نكتشف حالة من الارتباك الأخلاقي لا تقل غموضًا عن الأدوات ذاتها. فدار بينغوين راندوم هاوس، التي تُعلن التزامها الصارم بحماية الإبداع البشري والدفاع عن الملكية الفكرية، تُصرّح في الوقت نفسه بأنها ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية “بشكل انتقائي ومسؤول حيثما يظهر دليل واضح على فائدتها”. وكأنها تُمسك العصا من المنتصف: تُدافع عن نقاء الإبداع، لكنها تترك للآلة بابًا صغيرًا للعبور.
وعلى الجانب الآخر، تقف هاشيت المملكة المتحدة موقفًا لا يقل التباسًا. فهي ترفض “الإبداع الآلي” بوصفه نقيضًا لجوهر الكتابة، لكنها تشجع في الوقت نفسه “التجريب المسؤول” وتشيد بفضيلة البقاء فضوليين واحتضان التكنولوجيا. وكأن دور النشر تحاول أن تتعايش مع واقع لا ترغب في الاعتراف بأنه يغيّر قواعد اللعبة.
في هذا الوسط المتقلّب، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: إذا كان الكُتّاب يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي للعصف الذهني، أو التحرير، أو حتى الصياغة، فهل يقع على عاتقهم واجب أخلاقي بالكشف عن ذلك؟ هل يمكن للقارئ، الذي يدخل الرواية بافتراض أن الصوت الذي يقرأه هو صوت الكاتب وحده — أن يُعامل وكأنه طرف لا يستحق المعرفة؟ ثم، هل يكفي “الختم النهائي” للمؤلف لكي يُنسب العمل إليه بوصفه ملكًا خالصًا لخياله، حتى لو مرّ جزء منه عبر خوارزمية؟