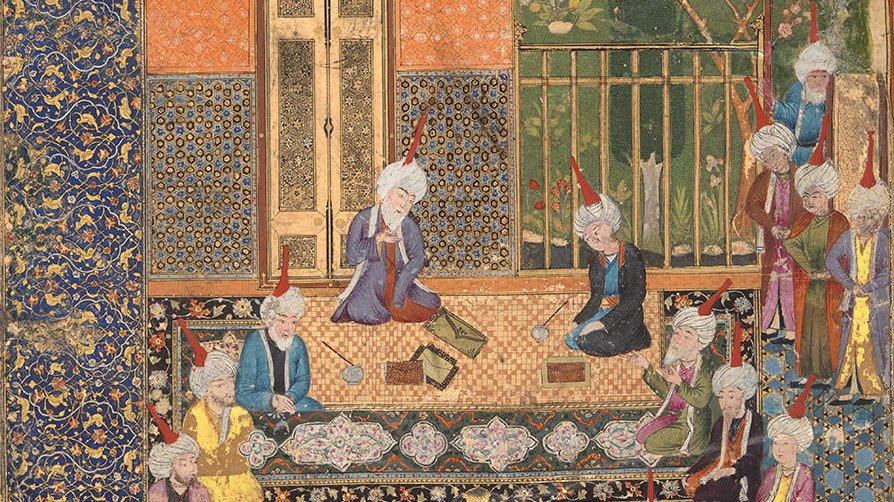تبدو مقالة “كيف تُصلِح حياتك في يوم واحد؟” وكأنها طوق نجاة لغريقٍ أرهقته الفوضى، فهي تُقدِّم وعدًا شديد الإغراء: أن تُمسك بزمام حياتك في أربعٍ وعشرين ساعة، وأن تخرج من دوامة التشتّت إلى صلابة المعنى. غير أنّ الإغراء نفسه هو أول موضعٍ يستحق المراجعة النقدية؛ لأن النص، وإن كان ذكيًّا في لغته ومحفِّزًا في إيقاعه، يخلط بين لحظتين مختلفتين تمامًا في علم النفس: لحظة “الوضوح الإدراكي” التي قد تحدث في يوم واحد بالفعل، ولحظة “التغيير السلوكي المستدام” التي لا تُنجَز في يوم ولا تُضمَن بالإلهام. قد تكتب في يوم واحد ما تريد أن تصبحه، وتكتشف في يوم واحد ما يستهلكك، وتسمّي في يوم واحد المشكلة التي تسكن قلبك كشوكة. نعم، هذا ممكن. لكن ما ليس ممكنًا بالطريقة التي يوحي بها النص هو أن يتحوّل ذلك الوعي فورًا إلى نظام ثابت، وإلى عادة راسخة، وإلى شخصية جديدة لا تتراجع ولا تتعثّر. هنا تحديدًا يقع المقال في ورطة نفسية خطيرة: ورطة “وهم المنعطف”، أي الاعتقاد بأن اتخاذ قرارٍ قوي وكتابة خطة مُحكَمة هو بذاته دليلٌ على أن التغيير قد بدأ فعلاً، وأن الاستمرار سيأتي تباعًا كأنه نتيجة تلقائية للوضوح. الواقع أن التغيير، في السلوك البشري، أشبه ببناء عضلة لا بإشعال شرارة؛ العضلة لا تتكوّن من لحظة حماس بل من تكرار رتيب، ومن تصميمٍ بيئيّ، ومن ضبطٍ للانتكاس قبل ضبط النجاح.
من المسؤولية إلى العار
وإذا كان هذا الخلط هو المشكلة الأولى، فإن المشكلة الثانية أشد حساسية: لغة المقال تُلقي بالقارئ من فضاء المسؤولية إلى فضاء العار. حين يُقدِّم النص تفسيرًا للفشل يُحيل إليه كتقصيرٍ في “الذكاء” أو نقصٍ في القدرة على التعلم من التجارب، فإنه لا يفتح باب التحسن بقدر ما يفتح باب التحقير الذاتي. من الناحية النفسية، العار لا يُنتِج تغييرًا صحيًّا طويل المدى؛ العار يصنع اندفاعة سريعة يليها انهيار، أو يصنع تجنّبًا للمحاولة أصلًا خوفًا من إثبات العجز. وهذا الفارق جوهري بين خطابٍ يساعد الإنسان على إعادة بناء ذاته، وخطابٍ يدفعه إلى جلدها. القارئ الذي يسمع ضمنًا أنه “غير ذكي” لأنه لا يتغير، لن يتغير لأنه فهم نفسه؛ سيتغير لأن هويته جُرحت، والجرح لا يداوي نفسه بالضغط. حتى حين ينجح، سيظل النجاح هشًّا لأنه مشروطٌ بالخوف من العودة إلى صورة “الفاشل”، وهذا تعريفٌ آخر لقلق الأداء، لا لتعافي السلوك.
ثم تأتي “الهوية” بوصفها الحلّ المركزي في المقال؛ وهنا يجب أن نتوقف طويلًا، لأن هذا موضع يتأرجح بين الإلهام والخطر. نعم، بناء العادات على أساس الهوية فكرة جذابة، وفيها من الحقيقة ما يكفي لاستعمالها؛ حين يَشعر الإنسان أنه شخصٌ منضبط، تصبح العادة امتدادًا طبيعيًا لا تكليفًا ثقيلًا. لكن المقال يقترح شيئًا قريبًا من قلب الهوية بسرعة، كأن الهوية قشرة يمكن خلعها في يوم وارتداء أخرى في اليوم التالي. هذه النظرة، من منظور علم النفس الاجتماعي والسلوكي، تبسيطٌ مربك؛ فالهوية ليست إعلانًا داخليًا فقط، بل هي تاريخٌ من الأفعال، وتكرارٌ للسلوك، واعترافٌ اجتماعي ضمنيّ، ومراكمةٌ للقدرة والكفاءة. حين تقول “أنا كاتبة”، لا تصبحين كاتبة لأنك قلتها، بل لأنك كتبتِ وتعثرتِ ثم كتبتِ، وتعلمتِ ثم كتبتِ، وانتظمتِ ثم كتبتِ، إلى أن صارت الكتابة جزءًا من نَفَسك. إن تحويل الهوية إلى “زر” يحمل خطرًا سلوكيًا عميقًا، لأن الهوية إن صارت صلبة أكثر من اللازم، يتحول أي خطأ صغير إلى تهديدٍ وجودي: يوم واحد بلا التزام يصبح “انهيار هوية”، وزلة صغيرة تصبح “دليلًا على أنني لست ذلك الشخص”. وهكذا، بدل أن تُستخدم الهوية كرافعة للتغيير، تصبح سوطًا يجلد الإنسان عند أول تعثّر.
الوكالة الفردية
ومع تضخيم الهوية، يبالغ المقال في تقديس “الوكالة الفردية” بوصفها مفتاح الخلاص النهائي: أنت تملك الإرادة، والفرص كثيرة، والذكاء يكفي، إذا أردت حقًا ستتغير. هذا المنطق، مهما بدا مشحونًا بالقوة، يعاني من عمى متكرر في أدبيات تطوير الذات: عمى السياق. لأن الإنسان لا يعيش في فراغ، ولا يتغير داخل غرفة نظيفة من الكلمات. البيئة تؤثر على السلوك أكثر مما يحب أصحاب القصص الفردانية الاعتراف به؛ النوم، والضغط المالي، والدعم الاجتماعي، والاستقرار العاطفي، والوقت المتاح، وطبيعة العمل، والقدرة على تقليل المشتتات… هذه ليست تفاصيل، بل هي الشروط التي تجعل إرادة اليوم قادرة على الاستمرار غدًا. والأخطر أن المقال لا يضع احتياطاتٍ للقارئ الذي لا يعاني من “كسل” بل من اضطراب يلتهم التنظيم التنفيذي؛ الاكتئاب ليس انعدام رغبة، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ليس ضعف إرادة، والقلق الشديد ليس نقص ذكاء، والصدمة ليست “حجة”. حين يغيب هذا التمييز يتحول النص إلى معيار أخلاقي قاس: من لا يتغير إذن لا يريد؛ ومن لا يريد إذن ضعيف؛ ومن هو ضعيف إذن يستحق فوضاه. وهذه نتيجة قاسية ومضللة في آن واحد.
الحفر النفسي
ولا يقل عن ذلك خطورةً ما يقدمه النص من أسلوب “الحفر النفسي” عبر أسئلة حادّة تحاصر القارئ: ما الحقيقة التي تخجل أن تعترف بها؟ ما السبب الأكثر إحراجًا لعدم تغيّرك؟ ما الذي تحمي نفسك منه؟ على الورق، تبدو هذه الأسئلة كأنها شجاعة، لكنها في الواقع قد تتحول إلى محكمة داخلية لا إلى مختبر للتغيير. الإنسان الذي لديه ميل للاجترار سيغوص في هذه الأسئلة كمن يغوص في مستنقع، يظن أنه يبحث عن الحقيقة بينما هو يزيد من توتره الداخلي. والإنسان ذو النزعة الكمالية سيحوّل “يوم الإصلاح” إلى يوم جلدٍ وسخط: إذا لم يخرج بكمالٍ كامل فهو إذن فشل. أما الإنسان الذي يحمل تاريخًا من الصدمات، فقد تستفزه الأسئلة دون أن توفر له وسائل احتواء، فيتحول الاستبصار إلى استثارة. إن أقسى ما في هذا النوع من الأدبيات ليس أنه يطرح أسئلة عميقة، بل أنه يتعامل مع العمق باعتباره بديلًا عن الفعل، في حين أن الاستبصار إذا لم يُترجَم إلى خطوات صغيرة، يصبح مادة لبناء سردية جديدة من العجز: “أنا أفهم نفسي جيدًا… ومع ذلك لا أتحرك.” وهذا أخطر من عدم الفهم.
وفي قلب هذا البناء كله، يستخدم المقال قوة “البداية الجديدة”؛ ذلك السحر النفسي الذي يجعل الإنسان يستعيد الأمل كلما بدأ سنة، أو شهرًا، أو أسبوعًا، أو حتى صباحًا. هذه القوة ليست وهمًا، لكنها سلاح ذو حدين. لأنها تُنتج نشوة البدء: شعورًا بأنك قد تغيرت لأنك قررت. ولأنها نشوة، فهي لا تُقيم وزنًا للهبوط الطبيعي الذي يأتي بعد أسبوعين أو ثلاثة حين تنخفض الدافعية ويظهر التعب ويعود التشتت. هنا يتكشف نقصٌ جوهري في المقال: غياب “جسر ما بعد النشوة”. ماذا سيحدث للقارئ حين يمر بأول أسبوع ثقيل؟ ماذا يفعل حين يتعثر دون أن يفسّر التعثر كفضيحة شخصية؟ أين أدوات إدارة الانتكاسة؟ أين نظام تعديل البيئة؟ أين مفاتيح الاستمرار حين يختفي الحماس؟ النص يعطي اندفاعة قوية، لكنه لا يبني شبكة أمان، ولذلك قد ينجح في إطلاق القارئ بسرعة، ثم يتركه ينهار بالسرعة ذاتها. وفي علم النفس السلوكي، ليست المشكلة في بداية ضعيفة، بل في استدامة بلا حماية.
لهذا كله، فإن المقاربة الأكثر دقة هي أن نضع المقال في حجمه الواقعي: هو نص ممتاز لإعادة تسمية الحياة، ولتحريك شعور السيطرة، ولخلق لحظة وضوح، لكنه ليس تفسيرًا علميًا كافيًا لتغيير النفس ولا دليلًا موثوقًا لتغيير السلوك. بل إن نقاط قوته البلاغية هي نفسها نقاط ضعفه النفسية؛ لأنه يبيع التبسيط، ويقدّم سردية شديدة اليقين، ويشعرك بأنك إذا فهمت فستفعل. بينما الحقيقة أن الإنسان قد يفهم ويظل عاجزًا إن لم تتغير شروط التنفيذ، وقد يريد ويظل بطيئًا إن كانت طاقته ممزقة، وقد يكون ذكيًا ويكرر الأخطاء لأن جهازه العصبي يعيش تحت ضغط أو قلق أو اضطراب. التغيير ليس فضيلة أخلاقية بقدر ما هو هندسة. ومن لا يتحول ليس دائمًا كسولًا؛ قد يكون مستنزفًا، أو غير محمي، أو بلا بيئة داعمة، أو بلا أدوات سلوكية دقيقة تحوّل النية إلى فعل.
ومع ذلك، لا ينبغي أن نرمي المقال كله؛ بل ينبغي أن نقرأه على حقيقته: “يوم واحد” لا يصلح حياتك، لكنه قد يمنحك شيئًا أهم من الحياة المثالية: يمنحك جملة واضحة عن نفسك. والجملة الواضحة بداية جيدة، لا نهاية سعيدة. البداية التي تستحق الاحترام هي التي لا تُسمِّي من يتعثّر غبيًا، ولا تُحمِّل الهوية أكثر مما تحتمل، ولا تُحوّل التغيير إلى اختبار شرف، بل تضع العقل في مكانه الصحيح: عقل يفهم، ثم يبني، ثم يتعثر، ثم يعدّل، ثم يستمر. تلك هي القوة الحقيقية، لا الوعد البرّاق.