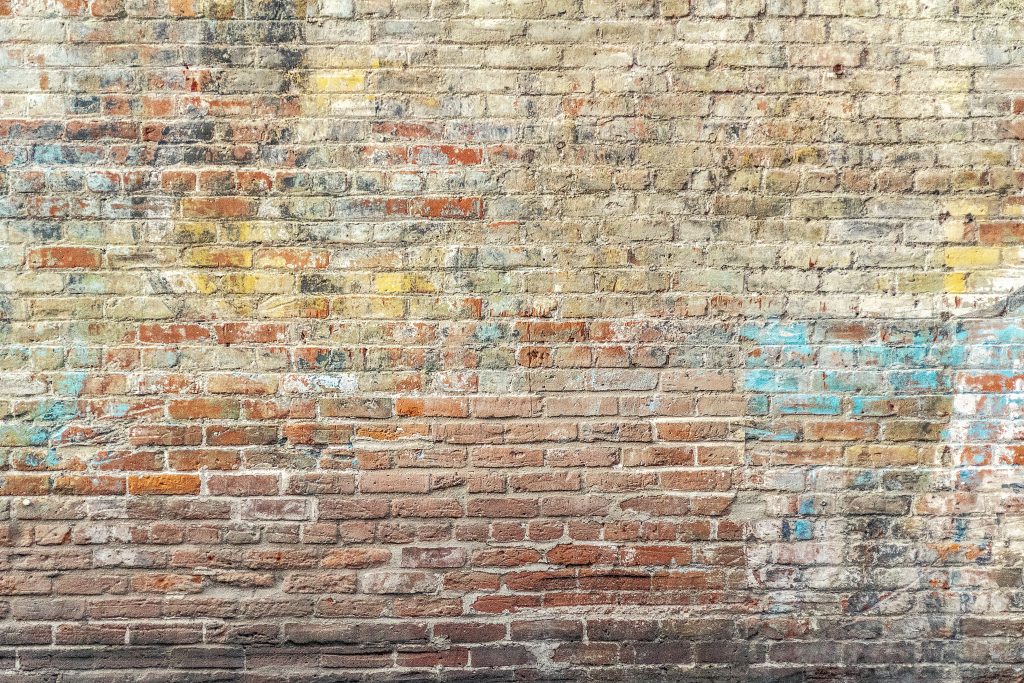قد لا يبدو الموضوع مثير للدهشة ولا يثير فضول القارئ، بسبب النظرة التقليدية التي جرت عليها العادة وذلك بالنظر للأمر من بعد منفعي بحت، بعيداً عن الجوانب الفكرية والاجتماعية التي كانت حصيلة لعلاقة الإنسان بالطبيعة؛ وهو ما نسعى للتطرق له بشكل متعمق في هذا المقال.
في البدء أود أن أوضح أن ما أقصده بالطبيعة هو كل ما هو موجود بالكون ولم يكن الإنسان سبباً في وجوده، ويدخل في نطاق هذا التعريف كل من البيئة والجغرافيا بما فيها من جبال وأودية وبحار وغطاء نباتي وحيواني. أي أن الطبيعة هي المحيط الذي عاش الإنسان فيه منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا. ولفهم الموضوع بشكل أعمق أجد أنه من الضروري بسط المقاربة التي تقوم عليها فكرة هذا المقال وهي إن علاقة الإنسان بالطبيعة مرت بثلاث مراحل:-
المرحلة | الحُقب الزمنية |
الخوف من الطبيعة | الحقبة الأولى: من أقدم العصور من 200 الف سنة قبل التاريخ حتى 5000 قبل الميلادالحقبة الثانية: تبدأ من 5000 ق.م إلى 300 ق.م |
التوائم مع الطبيعة | الحقبة الثالثة: من 300 ق.م -1500مالحقبة الرابعة: من 1500م- 1900م |
الإنسحاب من الطبيعة | الحقبة الخامسة: من 1900م – إلى يومنا هذا. |
* * * *
هنالك عدة تقديرات لتاريخ وجود الإنسان على الأرض، بعضها يوغل في القدم ويعود للخلف ملايين السنين، والبعض لا تتجاوز تقديراته 500 ألف سنة قبل التاريخ. وبعيداً عن هذه الاختلافات سنأخذ بالرأي الذي يرجح أن يكون عام 200 ألف قبل التاريخ هو التاريخ الأقدم للإنسان، ليكون نقطة انطلاقنا في تتبع حياة الإنسان وعلاقته مع الطبيعة.
من المؤكد أن الأرض تعرضت لعدة متغيرات جيلوجية ومناخية، ومنها العصور الجليدية، ويشير العلماء أن الإنسان قد عاش خلال العصور الجليدية على الأقل المتأخر منها “العصر الجليدي الخامس”. كما أن الأرض تعرضت لحركة وانزياح قارية وتغير شكل الأرض نتيجة هذه الحركة الجيولوجية، ومن الطبيعي أن تتأثر الحياة الفطرية والحيوانية بهذه التغييرات مما أدى لاختفاء بعض الأنواع الحيوانية نتيجة تغير ظروف الحياة المناسبة لها وكذلك المناخ. في ظل هذه التغييرات وجد الإنسان نفسه في محيط طاله الكثير من التغييرات وظروف العيش قاسية وكان عليه أن يتعلم ولم يجد خير معلم من الطبيعة. وبدأ رحلة التعرف على الطبيعة فلا مفر أمامه سوى التأقلم مع ظروفه وحماية نفسه للعيش بسلام. آنا ما
المرحلة الأولى: الخوف من الطبيعة:
الحقبة الأولى: من أقدم العصور من 200 الف سنة قبل التاريخ حتى 5000 قبل الميلاد
( الخوف والملاحظة والتجربة) بوصلة الإنسان في مراحله المبكرة
من الطبيعي أن تكون المشاهدات اليومية مصدر غني للملاحظة، فقد تعلم الإنسان من الطيور وطرائقها في الصيد وكذلك المفترسات، وبدأ يتعرف على أشكال مختلفة من الغذاء بدأ بأوراق الأشجار ثم البذور واللحوم النية. ومع التغيرات المناخية اضطر الإنسان للخروج من الغابات والنزول من الجبال للسهول حيث تتواجد الحيوانات والطيور، وتزامن ذلك مع تعلم الإنسان الصيد، ومن المحتمل أنه تعلم من طرق المفترسات في التربص بالطرائد وهذا الأمر دفعه لصناعة أسلحته ليحمي نفسه أولا من المفترسات ولتكون أداة تساعده في الصيد، لذلك فالسكاكين والفؤوس والرماح هي تقليد لأنياب الأسود والنمور وغيرها من السنوريات المفترسة. وكأن الإنسان يريد أن يمتلك أنيابه الخاصة لذلك استعان بالحجارة وقام بصقلها لتكون حادة وليحمي نفسه من الاشتباك المباشرة وضع هذه الحجارة المصقولة في سهام ورماح ليطلقها من مخبئه.
كانت التجربة التي تلي الملاحظة هي بوصلة تقدم الإنسان، فكلما تطور أدواته أنتقل لمرحلة أخرى وتعرف على عوالم لم تكن ظاهرة أمامه، فاكتشاف النار على سبيل المثال سمح له بالتنقل ليلاً وكذلك ساعدته النار على العيش في بعض المناطق المتطرفة مناخياً. والتغيير الكبير الذي غير من حياة الإنسان هو تعرفه على الزراعة، فملاحظته الدائمة للحبوب وهي تسقط في الأرض وتنبت دفعه للتجربة حتى اهتدى لطرق الزراعة.
التغييرات التي طالت حياة الإنسان بسبب الزراعة لا يمكن حصرها، فالزراعة سمحت للإنسان أن يمتلك فائض في الإنتاج وهذا الفائض يستخدمه لمقاضية منتاج أخرى، كما أن الزراعة دفعت الإنسان لتنظيم مجاري المياه والأنهار وظهرت فكرة الملكية “ملكية الأرض” فالأرض أصبح لها قيمة خصوصاً إذا كانت بالقرب من مجاري الأنهار، مع الوقت تطورت التقنيات المرتبطة بالزراعة مما أدى إلى تعلم الإنسان للكتابة فالمنتجات الزراعية تحتاج لرصدها وكمياتها كما أن التبادل فتح الباب على مصراعيه للتجارة التي لا يمكن أن تكون لها جدوى بدون تدوين. ربما هذا يفسر لنا سبب نشوء الحضارات القديمة على الأنهار مثل حضارة وادي السند وحضارة بلاد ما بين النهرين والحضارة المصرية.
لم يقتصر تأثير الزراعة على الجانب التقني “الكتابة” بل امتد للحياة الروحية، فأصبح الإنسان مرتبط بالمطر والماء وبدأ يخاف على زراعته من الفيضانات وهذا دفعه لتقديم القرابين للظواهر الطبيعية كالبرق والرعد كما قام بطقوس بهدف دفع السحاب لأن تهطل بما تجود به من خيرها. إضافة إلى ذلك قاده التأمل في عملية الزراعة لمقارنتها بالولادة والخصوبة، فالمحراث الذي يحرث الأرض ليهيئها للزراعة صنعه الإنسان بشكل يشبه القضيب وكأنها عملية جنسية، فشريكته في الحياة التي يودع فيها سائله الذي يتشكل ويصبح طفل ويبدأ بطن أنثاه بالنمو ثم تلد له كلها عملية تشبه الزراعة؛ فالأرض تستقبل البذرة وتبدأ تنمو تحت السطح ويرتفع سطح التربة وبعد فترة تخرج ساق النبتة كما يخرج ساق الطفل عند الولادة، لذلك أقدم أشكال العبادات كانت عبادة الأمومة. وعهد الإنسان للمرأة مهمة الزراعة لأنه ربط الزراعة بالولادة فكانت هذه أولى الوظائف التي ارتبطت بالنساء.
وخوف الإنسان على أطفاله من المفترسات وحماية أطفاله بأن يلقي ببقايا طعام لها لتأكله وتتركه بسلام قاده إلى تقديم الأضاحي للظواهر الطبيعية لتترك حقوله بسلام ولا يتعرض المحصول الزراعي للتدمير نتيجة الفيضانات أو البرد وغيرها من العوامل المناخية التي تؤثر على الزراعة.
في هذه الحقبة توسع تأمل الإنسان وبدأ يفكر في حياته ولم يفت عليه أن يفكر في اعقد مسألة أرقته وهي الموت. لذلك ومن تجاربه التي ارتبطت بالطبيعة كان يشاهد الأشجار وهي تموت واقفة وتتحطم ويخرج مكانها بعد مدة شجرة جديدة، واعتبر هذا مؤشر على حياة بعد الموت وأصبح الموت بالنسبة له رحلة لعالم آخر، حيث يعيش الموتى إلى جوار أسلافهم. وبناء على ذلك أهتم الإنسان بالأثاث الجنائزي للموتى وكان يجهز الميت بالمجوهرات والغذاء والسلاح ويدفن معه عبيده أو خيوله وحميره ليستعين بها في العالم الآخر. خصوصاً أن فكرة الخلود في الدنيا تحطمت في ذهنه ويمكننا استشعار ذلك من “ملحمة جلجامش” فالحزن الذي اعتصر جلجامش على صديقه أنكيدو دفعه ليبحث عن الخلود وقاده بحثه إلى اقتناعه بأن الخلود بعيد المنال وعليه أن يفكر في سعادته بالحياة الدنيا.
تميزت هذه الحقبة بأنها أطول عمر فقد احتاج الإنسان لمئات الآلاف من السنين حتى يستطيع أن يصل لمستوى يمكنه من بناء حضارة، عمر طويل قضاه في الملاحظة والتجربة والتعلم من الطبيعي قاده في نهاية المطاف لبناء أولى الحضارات البشرية، متناسبة مع تقنياته وأدواته التي استقاها من الطبيعة. كان الصبر رفيق الإنسان في هذه الرحلة فالوقت الطويل الذي قضاه في الملاحظة والتجربة والتقليد تطور بشكل بطيء ليتمكن البشر من استيعاب حياتهم وعلاقتهم مع الطبيعية. وكان الألف الخامس والرابع قبل الميلاد أشبه بمرحلة انتقالية بين مرحلتين، فأخذت التجربة تقفز مع تطور الأدوات التي استخدمها البشر في الصناعة ومع ظهر بيوت الطين والحجارة والسدود والقنوات المائية والمقابر الضخمة “الأهرامات” التي تقف شاهد على ازدهار ملكات التفكير عند الإنسان وقدرته على نقل أحجام ضخمة من الحجارة وتشكيلها بطريقة هندسية فذة. وتناسب هذا النمو مع الاتصال بين الجماعات البشرية في تلك الحقبة مما أسهم في عملية تثاقف نقل على إثرها الكثير من الخبرات بين البشر.
الحقبة الثانية: تبدأ من 5000 ق.م إلى 300 ق.م
تبدد الخوف و ولادة الفلسفة وتطور نظرة الإنسان نحو الطبيعة
في هذه المرحلة بدأت تتشكل ملامح نظرة الإنسان نحو الطبيعة وعلاقته معها، فقد كان الخوف والترقب هو سمت الحقبة الأولى التي امتدت لاكثر من مئتي الف سنة. وبزغ من هذه السنين العجاف افكار صاغة حياة الإنسان وعلاقته مع الطبيعة.
فعلى سبيل المثال، فقد كانت النظرة السائدة آنذاك أن الأرض مسطحة وتحتها طبقات من عوالم خفية هي عالم الأموات. أما السماء فهي فضاء شاسع مليء بالأسرار مجهولة للإنسان لذلك أكتفى بملاحظات عابرة مرتبطة بحاجته للملاحة كاهتمامه بحركة النجوم ونجم الشمال الذي استعان به في الملاحة وتحديد الإتجاهات، كذلك أهتم بحركة النجوم بسبب ارتباطها بالمواسم الزراعية والتغيرات المناخية، وربطها أيضا بالقدر مما أسهم في علو شأن الكهان والمنجمين وتشعب مهامهم.
بناء على ذلك تطورت معارف الإنسان وأصبح قادر على صناعة سفن قوية تبحر لمسافات طويلة خصوصاً انهُ تعرف على أنواع من الاخشاب المناسبة للبحار، كما تعرف على فوائد القار الذي استخدمه كعازل للمياه لحماية السفن من تسرب المياه. كما أن ملاحظاته لحركة الاسماك قادته لصناعة المجاديف بشكل يحاكي زعانف الاسماك.
هذا التطور التقني -بمعايير ذلك العصر، تواكب مع تطور على الجانب الفكري، فالفكرة تسبق الألة. فبدأ خوف الإنسان من الطبيعة بالتراجع وذلك بفضل الملاحظة وتطور الفكر وولادة الفلسفة التي قادت الإنسان لدهاليز مظلمة وإضاءتها. فلم تعد كثير من الظواهر الطبيعية كالبرق والرعد والبراكين والزلازل وكسوف الشمس تخيف الإنسان، فقد تشكلت تصورات علمية عنها وعن طبيعتها بغض النظر عن بدائية بعض هذه التصورات؛ إلا أن بعضها كان دقيق بشكل ملحوظ فقد تمكن طاليس Thales of Miletus (توفي عام 560 ق.م) من التنبئ بكسوف الشمس. وبرز فيثاغوروس Pythagoras (توفي عام 490 ق.م) الذي نبه على أن القمر جسم صلب كالأرض كما أنه أشتهر بقياساته الرياضية الدقيقة وقدرته على قياس محور الأرض والمسافات بين القارات، أما بارمنيدس Parmenides (توفي عام 480 ق.م) طرح فرضية كروية الأرض. وادلى افلاطون بدلوه عندما وصف حركة الأجرام السماوية وصفاً دقيقاً. وتطور أهتمام الفلاسفة بالطبيعة في هذه الفترة وكانت أغلب المؤلفات القديمة تدور حول الطبيعة وحول نشأت الكون لذلك كان الفلاسفة القدامى يسمون “الفلاسفة الطبيعيين” الفيزيقيين. هذا التطور الفكري أنعكس أيضاً على الدين، فقد تضعضعت الديانات الوثنية مع الكشوف العلمية التي حققتها الفلسفة وبدأ خوف الإنسان يتقهقر من هذه الظواهر، هذا الخوف هو الذي قاد البشر لعبادة الظواهر الطبيعية، فأصبحت هذه الظواهر مستقلة عن الآلهة الوثنية. وهذا يفسر لنا غضب شعب أثينا على سقراط Socrates (توفي عام 480 ق.م) واتهامهم له بأنه يفسد الشباب بتعليمهم تعاليم تعارض الدين، وكان هذا أول صدام بين المعرفة من جهة و الدين والتقاليد من جهة آخرى.
ويمكن تلخيص تصور الإغريق عن الطبيعة بأنهم اعتقدوا بأنها كائنا عضوياً وهذا التصور يقدم لنا الطبيعة بوصفها ذات حياة، وأن لها القدرة على الحركة وتجديد ننفسها بنفسها دون عون خارجي بسبب مبادئ وقوانين معقولة كامنة فيها، وبالتالي فالطبيعة تشبه الإنسان لها غايات تسعى لتحقيقها وقوانين تجري عليها الأمور، وهذا يعني أننا أمام طبيعة منظمة تنتفي فهيا المصادفة والعشوائية، هذا التصور للطبيعة يعرف بالنزعة الإحيائية Animism. أي النزعة لإحياء الأشياء الجامدة، وهو التصور الذي ساد فترة طويلة منذ طاليس الذي نبه على أن “الأشياء مليئة بالنفوس وإن المغناطيس له نفس لأن فيه قوة جذب الحديد” والنفس عند الإغريق مرادفة للحياة. وتصور اليونان أن هنالك عقل مدبر مرتبط بالطبيعة يدبر قوانينها وأن الساكن لايتحرك والمتحرك لايسكن إلا إذا حدث تدخل خارجي، وهو مادعاهم لمراقبة الطبيعة والتعرف على قوانينها والعمل بمقتضيات هذه القوانين والإستفادة منها في حياتهم العملية والفكرية وبهذا الشكل ينحصر دور الإنسان على اكتشاف القانون وليس أبتكاره. وهذا التصور ساد في هذه الحقبة حتى عصر النهضة.
هذا التصور عن الطبيعة قاد الإنسان لقرون عديدة لأن ينتقل من الوقوف متفرج على الطبيعة للسعي لإكتشاف قوانينها، وبدأ الإنسان يقلد الطبيعة بشكل واعي وذلك باعتبار أن قانون الطبيعة هو الخير وأن التوازن في الطبيعة يمثل الخير الأسمى وانعكس ذلك على المباحث الأخلاقية فبدأ الفلاسفة بمناقشة مسألة الخير والشر إنطلاقاً من تصوراتهم لقوانين الطبيعة، طبعاً لانغفل أن المسائل الأخلاقية والقوانين كانت مطروقة في وقت مبكر جداً ويمكن رصدها بسهولة في قانون حامورابي والقوانين المصرية القديمة، وماحدث على يد اليونان هو استكمال لهذه المسيرة الفكرية التي أنطلقت في الحضارات القديمة، وتطورت على يد اليونان بمناقشتها منطقياً وربطها بالقانون الطبيعي. وبفضل هذا التصور عن الطبيعة تمكن الإنسان من التقدم وتطوير الياته وادواته حتى تمكن من الإستفادة من القوانين الطبيعية في الحركة وذلك بالإستعانة بالاشرعة للإستفادة من قوة دفع الريح، وتمكن من تسخير الحيوانات في حركة النقل وقام بصناعة العربات ذات العجلات الدائرية التي تجرها الخيول والحمير لتسهل عليه عملية النقل، مستفيداً من قوانين الطبيعة وذلك عند رصده للحجارة الدائرية وهي تهوي من اعلى الجبال وتمضي مسافة طويلة وقام بتطوير الفكرة وصناعة دواليب دائرية خشبية لتكون كالقوائم للعربة لتجرها الحيوانات وتنقل بضائعه لمناطق بعيدة. كانت المركزية في هذه المرحلة للطبيعة فهي المركز وحولها تدور الأشياء ومنها الإنسان.
المرحلة الثانية: التوائم مع الطبيعة:
الحقبة الأولى: تبدأ من 300 ق.م –1500م
الإنسان يتقدم المشهد ويزاحم الطبيعة على مكانتها ليحل محلها
شكلت الفلسفة اليونانية الوقود الذي قاد المرحلة الثالثة خصوصاً مقولات أرسطو حول الطبيعة، فقد مر معنا أن الفلاسفة المبكرين كان يطلق عليهم بالفلاسفة الطبيعيين لأنهم كانوا يبحثون عن أصل الكون والوجود، وعندما جاء أرسطو نقل السؤال إلى العلة وماخلف الطبيعة وماهي العلل التي تحرك الطبيعة لاعتقاده بأن هنالك قوانين تحرك الطبيعة وسميت كتاباته في هذا الباب بالميتافيزيقيا. وكان محور أهتمام أرسطو ينصب على الأسباب التي تقف خلف الظواهر الطبيعية وقدم أرسطو أربع علل وهي (العلة الصورية والعلة الغائية والعلة الفاعلية والعلة المادية) وتبسيطها أنه لصناعة سرير من خشب نحتاج لنجار يصنعه وإلا لن يوجد سرير لذلك يصبح النجار علة فاعلية، ونحتاج أيضا إلى خشب مادة وهو العلة المادية، كما أن السرير لايوجد بدون تصميم وشكل في ذهن النجار وهذه تسمى علة صورية، واما الحاجة التي صنع من اجلها السرير ليستخدم ويباع فتسمى علة غائية. هذا السياق المنطقي سمح بإنطلاق العقل لاكتشاف الطبيعة وحفز العقل على الإنطلاق نحو مجاهيل لإكتشافها.
أسهمت المرحلة الثانية في دفع التقدم العلمي والتقني بشكل كبير وتواكب معها تقدم فكري، وعندما وصلنا للقرن السادس عشر الميلادي كان منطق أرسطو قد أستهلك وبدأت افكار جديدة بالظهور مع بزوغ عصر النهضة وكان أهمها تصور الإنسان حول الطبيعة فقد تصورها علماء عصر النهضة أنها طبيعة عاجزة عن الفعل بذاتها تتصف بالقصور الذاتي وهي بحاجة لمن يوجهها أي بحاجة لقوة خارجية لتغيير حالتها وظهر هذا التصور على يد ليوناردو دافنشي Leonardo da Vinci (توفي عام 1519م) ثم جاليليو Galileo (توفي عام 1642م) وبلغ ذروته عند نيوتن Newton (توفي عام 1727م) وهذا التغير في النظر للطبيعة كان بمثابة ثورة شاملة جرفت في طريقها كل المفاهيم والمبادئ التي بني عليها التصور الإحيائي للطبيعة وطمس سذاجة التصور القديم وبدأ ببناء صرح جديد اختلفت فيه علاقة الإنسان مع الطبيعة، فبدلاً من أن تكون الطبيعة هي المركز تحول الأمر وأصبح الإنسان هو المركز وتقهقرت الطبيعة للهامش. وبدأ الاعتزاز بالعقل والبحث عن السبل التي تسهم في رفاه الإنسان وتقدمه وفرض هيمنته وسلطانه على الطبيعة، وانعكست هذه الثورة على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والعقائدية. واتجه الإنسان بقوة إيمانه بعقله ومكانته لإعادة صياغة العالم بما يتوافق مع طموحه وبما يتناسب مع مركز الصدارة الذي اصبح شاغراً له وحده دون سواه.
اذا بحثنا عن تصور يختزل المشهد يمكننا أن نستعين بقانون القصور أو قانون العطالة عند نيوتن ويقول هذا القانون أن الجسم المادي يمتلك مقاومة لتغيير حركته من السكون إلى الحركة، وهو ميل أي جسم فيزيائي لمقاومة التأثيرات الخارجية المفروضة عليه نتيجة لفرض قوة خارجية. ويعلق كانط Kant (توفي عام 1804م) قائلا “عندما ترك جاليليو كرات ذات أوزان معينة حددها بنفسه تنزلق فوق سطح مائل – وهي التجربة التي توصل بها جاليليو لقانونه عن القصور الذاتي- شع ضوء مبهر أمام كل الباحثين في الطبيعة. فقد أدركوا أن العقل قادر على أختراق حجب الطبيعة وأن عليها أن تتحرك وفق مبادئه وأحكامه، وأن تجيب عن أسئلته. فالعقل قابض بيد على مبادئه وباليد الأخرى على التجربة الخاضعة لهذه المبادئ، يجب أن يقترب من الطبيعة ليتعلم منها ولكن ليس كتلميذ يوافق معلمه على كل شيء، بل كقاضٍ يجبر الشهود على الاعتراف“.
بهذا الشكل حلت فكرة الآلية محل الطبيعة العضوية، بمعنى أن الطبيعة ليست منظمة بذاتها، وليست قادرة على تدبير أمورها بقوانينها وأنها موجهة داخلياً لغايات هي التي حددتها بنفسها، بل طبيعة مذعنة لما يفرضه عليها العقل من قوانين تشهد بعظمته. ومن ثم لم يعد القانون العلمى اكتشافاً لما هو كائن بل هو إبداع من ابتكار العقل الإنساني. ومما عزز من فكرة الآلية في ذلك العصر، انتشار صناعة الآلات ذاتية الحركة التي من صنع الإنسان كالساعات ذات التروس التي تحركها زنبركات. وهكذا أصبحت الطبيعة وكأنها آلة كبيرة، تروسها الظواهر، وكما أن حركة أي ترس في الآلة هي نتيجة لحركة ترس سابق، وفي نفس الوقت سبب في حركة ترس لاحق. كذلك كل ظاهرة في الطبيعة هي سبب في حدوث ظاهرة لاحقة، ومسببة لظاهرة سابقة، وهو مانراه واضحاً في قانون الفعل ورد الفعل.
هذا التغير في نظر الإنسان للطبيعة دفعه للتفكير في كل السبل التي تساعده للسيطرة عليها وفرض نفوذها لأنها بحسب التصور السائد آنذاك تعتبر طبيعة جامدة وبدأت خميرة افكار القرن التاسع عشر وقانون التطور الذي يعتبر تمر للإنسان على الطبيعة وثورة على كل ماقبلها، فظهر مع دارون فكرة النشوء والتطور والتي يمكن اختصارها بأن الكائنات تتطور بحسب التحديات والظروف وتكتسب سمات تجديدة لتصمد، بينما هنالك كائنات لاتستطيع أن تواكب التحديات وتندثر وتختفي. هذه الفكرة ثورة في الفكر البشري، فأصبح الإنسان يبحث عن مبدأ التطور ويعيد قراءة التاريخ من هذه الصورة، ويعتبر أن هنالك سلالات من البشر إندثرت بسبب عدم قدرتها على التطور، كما برزت اراء تعيد التفكير في مسألة أصل الإنسان وأنه تطور من سلالات من القردة حتى أصبح الإنسان العاقل الحالي الذي خرج للوجود بحسب مدرسة التطور قبل مئتي الف سنة خلت. كما أن فكرة التطور دفعت الإنسان لاعتبار أنه هو الاسمى والارقى من ضمن الكائنات وأن قانون الطبيعة “التوازن” لايمكن أن ينطبق عليه فالإنسان مجبول على الغلبة والسيطرة وبسط نفوذه والبقاء للأقوى. وبدأ الإنسان يعتبر أن القوة هي المحرك الأول للإنسان الذي تمكن من الصمود طويلاً أمام تحديات عويصة. لذلك بدأ عصر القوة ولا اعتبار أخر للقوة.
الحقبة الثانية: تبدأ من 1500م- 1950م
الإنسحاب من الطبيعة والبقاء للأقوى القوة بوصلة الإنسان
سمح قانون “البقاء للاقوى” والذي هو انعكاس لتصور الإنسان عن الطبيعة، كما أنه أمتداد لفكرة أن الطبيعة جامدة خاملة قاصرة، بأن يفرض الإنسان قوته على الطبيعة ويسرف في استنزافها وذلك بقطع الغابات والتوسع في المصانع التي تعتمد على الفحم ثم الوقود السائل، ومع تطور الصناعات والآلات زاد استهلاك الإنسان للطبيعة وتدميرها، وذلك باعتبارها خادمة للإنسان ويجب عليها أن تلبي رغباته المتزايدة في المتع والرفاهية، وهذه الحركة الصناعية زادت من كمية التلوث كما أنها أسهمت في اندثار الكثير من الغابات والقضاء على قطعان من الحيوانات البرية لتلبي رغبات الأسواق التي لا تشبع من البحث عن المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الاستهلاكية المختلفة.
مرت قرون عديدة من التدمير المنظم للطبيعة لتلبي رغبات الإنسان التي لا تنتهي ليصل الإنسان لمرحلة يدرك فيها أن القوة المفرطة التي واجه بها الطبيعة تكاد أن تقضي على حياته، خصوصاً مع زيادة التلوث البيئي واختلال التوازن الطبيعي. ومن رحم هذا العصر بدأ يظهر عصر جديد وهو تصحيح لتصور الإنسان عن الطبيعة فظهر أنشتاين بقانون النسبية وفيزياء الكوانتم التي اعتبرت أن المادة ليست جامدة بل متغيرة ومتحركة وتتبدل، وإعادة الاعتبار للطبيعة وذلك بإحياء التصور القديم بأن هنالك قوانين طبيعية يجب أن يعاد النظر فيها ويرد لها الاعتبار. وعلى الرغم من هذا التغير الذي حدث مع مطلع القرن العشرين إلا أن نفوذ المرحلة الثالثة امتد إلى الحرب العالمية الثانية وذلك بصناعة قنبلة نووية أسهمت في قتل ملايين من البشر ونزوح الملايين بسبب التلوث البيئي سواء من استخدام القنابل بشكل مباشر كما حدث في هيروشيما ونجازاكي أو بسبب التجارب النووية أو التسرب النووي كما حدث في تشرنوبل. عندها بدأ الإنسان يفطن لحجم العنجهية والقوة التي أوصلته إلى مشارف الهاوية وبدأت مرحلة جديدة وهي المرحلة التي نعيشها حالياً وهي انسحاب الإنسان من الطبيعة والمقصود بانسحاب الإنسان من الطبيعة هو ابتعاده عن الحياة في الطبيعة وعن تأملها والاستفادة منها لإثراء حياته الروحية كما فعل أسلافه منذ آلاف السنين، وهنالك عدة عوامل أدت إلى تسار وتيرة انسحاب الإنسان من الطبيعة وألقت به في حياة وهمية خلف جدران إسمنتية منفصلا عن علاقة تجاوزت المئتي ألف سنة تاركاً وراءه العديد من المكتسبات التي اضطر للتنازل عنها مكرهاً.
المرحلة الرابعة: إنسحاب الإنسان من الطبيعة 1950م – إلى يومنا هذا
التقدم العلمي الهائل أسهم في رفع الغطرسة عند الإنسان بأن يعتبر نفسه فوق كل شي، فلم يعد يردعه أي رادع عن التجارب النووية التي أفسدت آلاف الكيلومترات من الأراضي البكر، ولم يلقي بالاً بالمياه الملوثة التي يلقيها في الأنهار والبحار، وأكوام النفايات البلاستيكية التي تتراكم بالأطنان، والغابات التي بدأت بالاختفاء، كل هذه الغطرسة أسهمت في ابتعاد الإنسان عن الطبيعة، وتحول غابات إلى مدن أسمنتية تغيب فيها المظاهر الطبيعية باستثناء طيور حائرة تتنقل بين الأشجار أو حيوانات أليفة يعتني بها أصحابها، كما أن الدروس التي استفاد منها أجدادنا في عيشهم بالطبيعة أصبحت خلف ظهورنا، فلم تعد تربطنا بالطبيعة أي رابط باستثناء نزهة متواضعة نقوم بها في الحدائق العمومية أو في رحلة برية مرة أو مرتين بالسنة. الاتصال والتوائم مع الطبيعة الذي صنع الفكر البشري منذ ثلاثة آلاف سنة أصبح يقف حائر أمام ناطحات السحاب وكربون السيارات، لم يعد هنالك دروس وعبر يمكن استخلاصها.
وزاد من الطين بلة أن التقدم العلمي وتطور المواصلات والاتصالات، جعل الإنسان يركض نحو المستقبل ويتعرض لصدمة المستقبل كما يطلق عليها ألفين توفلر. ومع هذا التقدم العلمي تزداد الخسائر التي نتعرض لها نتيجة ابتعادنا عن البيئة ويتوسع الشق بينا وبين الطبيعة.
وأول درس تعلمه الإنسان من الطبيعة هو التأني والصبر وأخذ وقته في فهم ومعالجة المشاكل التي يمر بها، فمن ميزات الطبيعة التأني، ولا أريد أن أقول البطيء حيث كلمة بطئ محملة بثقل سلبي لا طائل من دفعه في هذه السطور. فالطبيعة تتحرك بشكل متأني والانتقال بين مواسمها المناخية كالصيف والشتاء يكون بشكل هادئ يسمح للإنسان باستيعاب التغيرات ويحتاط بتدفئة نفسه أو تخفيف ما أثقل كاهليه من ملابس، كما أن نمو النباتات يأخذ وقته وكذلك ذوبان الجليد وظهور المروج الخضراء، هذا التأني سمح للإنسان بأن يتأمل ويفكر وكذلك أمده بالصبر، بينما التغيرات السريعة التي تحدث في الطبيعة كالزلازل والبراكين فغالباً نتائجها وخيمة ومدمرة، وكأن الإنسان يقف أمام خيارين “التأني” و “السرعة”، والأخير أصبح خيار الإنسان في الوقت المعاصر وهو بكل تأكيد من نتاج التقدم العلمي والتقني ومرتبط في المقام الأول بالتقدم في صناعة الآلات التي امتازت بالسرعة الخارقة والتي سمحت للإنسان من قطع القارات والصعود للفضاء. إذن نحن أمام خيارين الأول “التأني” وهو الذي صنع الحضارة الإنسانية الخالدة، وخيار “السرعة” وهو المسؤول عن الحضارة المادية الاستهلاكية. وسنقوم بوضع جدول مقارنة بينهما في مجالات عديدة.
التأني – الطبيعة الفكرة | السرعة – الالة نقيضها |
التفكير والتأمل | الأختيار والتقليد |
الذكريات (رسائل الورقية، عيش اللحظة) | النسيان (رسائل سناب، رسائل اكترونية) |
الدهشة والإكتشاف | المعاينة |
علاقات إنسانية | علاقات إستهلاكية (اترك ما يؤذيك..الخ) |
الصبر والروتين | الضجر والتغيير |
السماع | المشاهدة |
الهوية | القوالب الشخصية |
من المفيد أن ينعكس حديثنا السابق على حياتنا اليومية وعلى طبيعتنا الجغرافية كعرب عموماً وكسعوديين خصوصاً. فمن المتفق عليه عند العلماء أن الطبيعة عامل مهم في صنع الهوية ولها أثر بارز على حياتنا وذاكرتنا الجماعية، فكيف يتم ذلك.
تشكل الصحراء النسبة العالية من جغرافية الجزيرة العربية، بل أن أغلب بلدان العالم العربي هي دول تخترقها وتفصلها الصحراء وتشكل الصحاري ما نسبته 60% من جغرافيا العالم العربي. فصحراء تدمر تتوسط بين العراق وبلاد الشام، وصحراء الحمادة تفصل بلاد الشام عن الجزيرة العربية، وتقوم حضارة مصر على نهر النيل الذي يتوسط الصحراء الشرقية والغربية كما أن صحراء سيناء تقف في منتصف الطريق بين مصر وبلاد الشام. وشمال أفريقيا من ليبيا حتى موريتانيا تشكل الصحراء النسبة العالية من جغرافيته. وتأتي الجبال والواحات والأنهار لتأخذ النسبة المتبقية من جغرافيا العالم العربي. وهذا ما يوضح أن الكثير من مفردات اللغة العربية مشتقة من الصحراء وكذلك الحكم والأمثال.
فعندما كان الإنسان العربي يقطع هذه القفار لم يكن يملك رأس مال سوى راحلته وسمعته، وكان العربي يستثمر في علاقاته الإنسانية لتكون رأس مال اجتماعي يستخدمه عند الضرورة فالكرم في أوقات ضيق اليد كان يجلب على صاحبه صيت اجتماعي استثمره إنسانياً، كما أن الشجاعة ضرورية للعيش في ظروف قاسية لا ترحم، هذه الظروف رفعت من قيمة التكاتف الاجتماعي وغذت منظومتنا القيمية بمعاني سامية من الإخاء والتلاحم.
كما أن البحر الذي كان مصدر رزق سكان الساحل علم هؤلاء على أن الحياة تحتاج للصبر والأمل، ففي الأفق البعيد ستظهر يوماً بشائر الخير بعودة الغائبين ويحمل الجديد والدهشة، وكان الانتظار مغموس بطينة المروءة الاجتماعية بتكاتف اجتماعي يخفف عبء الانتظار على عوائل الغائبين.
وفي أعالي قمم جبال السروات كانت عزيمة الإنسان صلبة كصلابة الجبال، فتعلم أهلها استثمار المناطق الصالحة للزرعة كما علمتهم الطبيعة أن يكونوا حذرين من تقلبات الزمان مثل حذرهم من السيول المنقولة التي تدمر كل شي في طريقها، والمشي بالجبال كان محفوفاً بالمخاطر لذلك كان الواحد منهم يستوثق مع موطئ قدمه لكي لا يقف على صخرة تهوي به، وهذا انعكس على تعاملاتهم وحياتهم فلا يقطع بأمر حتى يتأكد منه ويستوثق أن يقف رأيه.
على طول هذه الرحلة الطويلة كان الناي والربابة والطار أنيسهم فهي أدوات من بيئتهم تتحمل تقلبات المناخ وتصدح بأنغام تحاكي الطبيعة وتبث شجونهم وأفراحهم، هذه المسيرة الطويلة من تاريخنا كان وقودها الصبر والتأني.
فالطبيعة المتأنية تسمح للإنسان بالتفكير والتأمل بالحياة والكائنات بينما الآلة التي تقوم على السرعة لا تسمح إلا بالاختيار والتقليد، فالدعايات تقوم على كم هائل من المؤثرات السريعة التي تفقد الإنسان ملكة التأني والتفكير وتدفعه بقوة تأثير الألوان والعبارات الجاهزة “أفضل منتج، الأكثر مبيع..الخ” إلى الاختيار. وينطبق الأمر على الذكريات فالرسائل الورقية التي كانت تحتاج لفترة طويلة لتصل للأهل والمحبوب تحمل معها الشوق والتوق وتصبح الورقة جزء من الإنسان يحتفظ بها ويقرأها مدى الحياة ما لم تتلف، بينما الرسائل الإكترونية كرسائل السناب والإيميل عرضه للتلف بشكل كبير سواء بضياع الرقم السري أو تعرض الحساب للسرقة أو حذفها بالخطأ كما أنها ليست ملموسة كالورق وسرعة وصولها تقتل لذة الانتظار والتلهف.
أسهمت السرعة أيضا في جرف متعة إنسانية أصيلة وهي الاكتشاف، ففي الغالب عندما نسافر لدولة تكون صور والتغطيات قد سبقتنا ونحمل تصور كامل عن الدولة وكل شي فيها، نحن نسافر لنعاين ما سبق أن شاهدناه بوسائل التواصل الاجتماعي، كذلك الحال في المقاهي والمحلات التي نزورها، بينما سابقاً كان الإنسان يسافر وهو لا يعرف عن الدولة سوى اسمها وعملتها ويستمتع بلذة الاكتشاف اكتشاف الجديد سواء كان جيد أم سيئ هذه اللذة الأصيلة بدأت بالتلاشي.
وانعكس الأمر أيضا على العلاقات الإنسانية، فالوقت الطويل الذي تقضيه رحلة بين مدينتين تسمح للإنسان بالتعرف على رفاقه في الرحلة واكتشاف علاقات إنسانية قد تكون أوثق من علاقتنا مع أخوتنا، قد نكتشف علاقات إنسانية تغير حياتنا للأفضل وقد نكتشف من يساعدنا في فهم أنفسنا ويكون خير معين لنا في هذه الحياة. بينما في وقت السرعة لا يسمح الوقت بذلك، فمع ربط أحزمة الطائرة تربط معها اكتشفات اجتماعية وإنسانية مؤجلة إلى أجل غير مسمى.
مالعمل؟
هنالك العديد من الحلول التي يمكن أن يقوم بها الإنسان لإعادة التوازن والتناغم لحياته مع الاحتفاظ بمكتسبات الحياة المدنية التي صنعتها الحداثة، وتقوم هذه الحلول على مساعدة الإنسان لاكتساب ماخسره ومنها الصفاء الذهني والصبر والتركيز، والابتعاد بقدر الإمكان عن المشتتات، والقيام بأنشطة تأخذ وقت كافي لإعادة الذهن لصفاءه، ومن هذه الأنشطة
1-القراءة والكتابة: فالقراءة والكتابة تساعد الإنسان أولا على التعرف على عالمه من خلال قراءة التجارب الشخصية كالسير الشخصية والروايات لكسب بعد إنساني وثقافي وإثراء الحياة، كما أن الكتابة تسهم في تخفيف الضغط وتساعد في تفريغ الضغوط الحياتية التي يتعرض لها الإنسان من خلال كتابة المذكرات الشخصية أو خواطر بغض النظر عن التقاليد المعتبرة في الكتابة فالأمر شخصي في المقام الأول.
2-ممارسة الهوايات اليدوية: فالهوايات اليدوية كتشكيل الفخار والصناعات الطينية والخياطة والعزف على الآلات الموسيقية والرسم والزراعة المنزلية؛ تسهم بشكل كبير في إعطاء معنى لحياة الإنسان وبث الفرح والسرور بالإنجاز الذي يحققه فيها.
3-التنزه في الطبيعة والرحلات البرية: هنالك العديد من الخيارات التي قد يلجأ لها الإنسان للرحلات في الطبيعة كالرحلات القصيرة مع المجموعات “الهايكنج” أو الرحلات الطويلة “التخييم” والخيار بحسب قدرات الشخص ووقته، وما يميز الرحلات في الطبيعة هو أنها تمد الإنسان بطاقة جديدة وشعور بالدهشة لاكتشاف الجديد وتمد الإنسان بالفرح لخلوته مع الطبيعة وابتعاده عن المشتتات التي ارتبطت بحياتنا المدنية.
4-المشي وممارسة الرياضات الهوائية: من المؤكد أن المشي والممارسات الهوائية والتأملية كاليوجا، تسهم بشكل كبير في إعطاء الإنسان توازن بحياته اليومية.
5-التقليل من الاعتماد على التقنية والاعتماد على الذاكرة: وذلك من خلال استخدام الذاكرة الخرائطية الذهنية في حال كان الشخص يرغب بالذهاب لمكان بدلاً من استخدام جوجل ماب، وكتابة الملاحظات على الورق بدلاً من كتابتها على الجوال، وكتابة الرسائل على الورق قبل أن تكتبها على الكمبيوتر أو الجوال، واستخدام العقل في العمليات الحسابية بدلاً من الآلة الحاسبة وغيرها من الأنشطة التي وقفت الآلة والتقنية حائلاً بينها وبين العقل.
6-الاكتشاف: عندما تزور مكان جديد حاول أن لا تقرأ عن تقييمه أو تقارير مصورة عنه، حاول أن تتجول بالسيارة أو مشياً على الأقدام والدخول لأماكن جديدة والتعرف عليها لتعيد للدهشة نشاطها وذلك باعتمادك على الاكتشاف بدلاً من معاينة ما سبق شاهدت تقرير عنه.
7-تغذية الروح: على الإنسان أن يستمد من مراقبته للطبيعة دروس تغذيه روحياً وتعزز من قدرته على التحمل وتخطي الصعاب، فالوقت الذي نعيش فيه بتقلباته وأهوائه حمل معه ثقل نفسي رهيب، يكاد بعض الناس أن يسقط صريعاً من تبعيات الضغط النفسي الذي يعايشه.
وقد استمد الفلاسفة الرواقيين Stoicism من الطبيعة الدروس، فمثلما يوجد تنوع نباتي وحيواني وجغرافي كذلك هنالك تنوع في عقليات الإنسان ونفوسهم وأمزجتهم، ويوصينا ماركوس أوريليوس Marcus Aurelus بأن نقول لأنفسنا كل صباح “قل لنفسك حين تقوم في الصباح: اليوم سألقى من الناس من هو متطفل ومن هو جاحد ومن هو عات عنيف؛ وسأقابل الغادر والحسود ومن يؤثر نفسه على الناس. لقد ابتلي كل منهم بذلك من جراء جهله بما هو خير وما هو شر، أما أنا فقد بصرت بطبيعة الخير وعرفت أنه جميل وبطبيعة الشر وعرفته قبيحاً…فلن يسوءني أي واحد من هؤلاء ولن يعديني بإثمه.” التأملات، ص 42
وفي موضع آخر يقول ماركوس أوريليوس: “كن مثل رأس الأرض في البحر تتكسر عليه الأمواج بلا انقطاع وهو ثابت وطيد يخمد من حوله جيشانُ الماء” التأملات، ص 86.
وعن فعل الخير ورد الجميل يشير ماركوس أوريليوس لمبدأ مهم “من الناس من إذا أسدى جميلاً إلى شخص سارع بتسجيله في حسابه كدين مستحق، ومن من لا يسارع بذلك غير أنه يضمر في نفسه أن هذا الشخص مدين له ويعي جيداً بما فعله. وهناك صنف ثالث هو بمعنى ما لا يعي ما أتاه ولا يحشد له ذهنه، وإنما هو كالكرمة التي أهدت عناقيدها ولاترتقب أي مقابل، كالنحلة وقد أفرغت عسلها بدون أن تنتظر مقابل وإطراء“. التأملات، ص 94.
وأهم هذه الدروس أن يحفظ الإنسان صفاءه الذهني والنفسي، ولا يسمح للآخرين بأن يحولوا عقله وقلبه إلى مكب لنفاياتهم الأخلاقية وعقدهم النفسية، وفي هذا السياق يشير ماركوس أوريليوس لتشبه الإنسان بالنهر “كيف يمكن لهم أن يحولوا بين عقلك والصفاء، والحكمة والرصانة والعدل؟ هب واحداً أتى إلى نبع من الماء النمير وأخذ يلعنه، فهل سيمنع النبع من أن يظل يتدفق بالماء؟ وهبه ألقى فيه بشيء من الطين والروث.. فلن يلبث النبع أن يفتته ويزيحه ويعود إلى نقائه، كيف إذن تؤمن لنفسك نبعاً دائماً لا مجرد صهريج؟ بأن توطن نفسك طول الوقت على الحرية“. التأملات، ص 174.
للمزيد من التفاصيل والإثراء يمكنكم الرجوع للكتب التالية:
-فيليب ديسكولا، ما وراء الطبيعة والثقافة، ترجمة عزالدين الخطابي، هيئة البحرين للثقافة والآثار، 2019م.
-ر. كولنجوود، فكرة الطبيعة، ترجمة أحمد حمدى محمود، المركز القومي للترجمة، 2020م.
-فرانسوا بون، عصور ماقبل التاريخ بوتقة الإنسان، تترجمة سونيا محمود نجا، المركز القومي للترجمة، 2013م.
-Alvin Toffler, Future Shock, 1970.
-ماركوس أوريليوس، التأملات، ترجمة عادل مصطفى، دار رؤية، 2010م.
-إبكتيتوس، المختصر، ترجمة عادل مصطفى، دار رؤية، 2019م